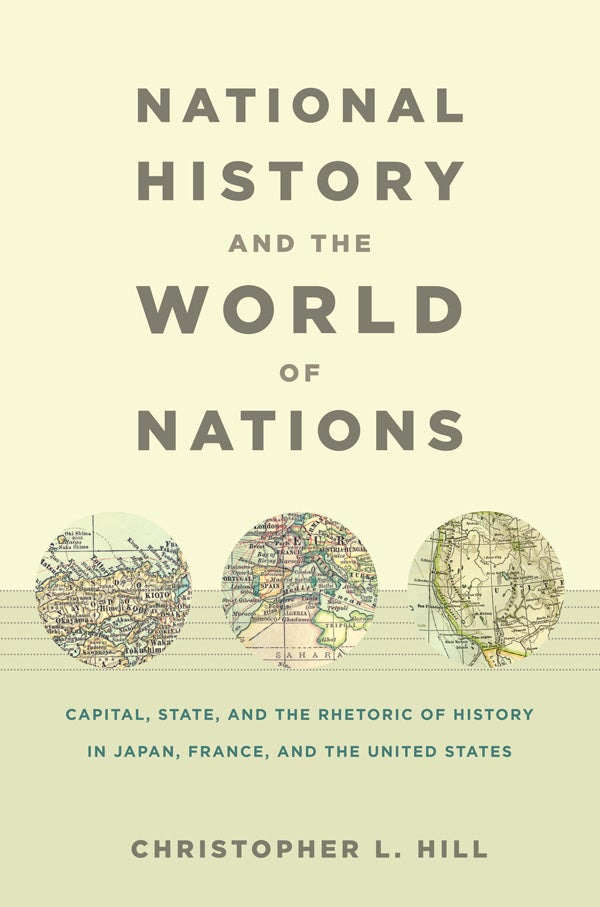المن والسلوى في نقد أطروحة كتاب "سياسة التقوى"
عن الفاعلية والذات وتشكلاتهما
لا أحصي عدد المرات التي قررت فيها قراءة كتاب معشعش على أرفف مكتبتي، ثم ندمتُ على تأجيل قراءته. كان آخرها كتاب التاريخ القومي وعالم الأمم للمؤرخ كريستوفر هيل، والذي تمنيتُ لو قرأته قبل سنتين أو ثلاث في بدايات اهتمامي بتبعات الآيديولوجيا القومية (nationalism) على القراءات المعاصرة للتاريخ الإسلامي المبكر.
من بين أفكار الكتاب الرئيسية، لفتتني جزئية حول الانقلاب الإبستيمي الذي يعيد ترتيب الظواهر المتزامنة على طول خط زمني تعاقبي غائي، انقلابٌ يستكشفه الكاتب من خلال تحليل الأعمال الأدبية والفكرية في كل من اليابان وأمريكا وفرنسا أواخر القرن التاسع عشر. هذا الانقلاب الإبستيمي وتوظيف الآداب في كتابة التأريخ أمران ذوا صلةٍ مباشرة بالعديد من اهتماماتي الخاصة، وكانا ليساعداني في صياغة العديد من الأسئلة البحثية.
لكن هذه الخربوشة ليست عن كتاب كريستوفر ولا عن القومية ولا عن تأريخ الأفكار. عارف، يا ما زهّقت طوايفكم بها. استحضرتُ المثال من باب ندمي على تأجيل قراءة الكتاب مدة طويلة وحسب. إذ على عكس تجربتي الرائعة معه، مررت قبل يومين بنقيضها مع الكتاب موضوع هذه الخربوشة، أي سياسة التقوى للأنثروبولوجية صبا محمود. بعد تسويف دام قرابة التسع سنوات، انتهت الرحلة مؤخرًا بخيبة أمل كبيرة.
الزبدة لمن لا يتحمل الشدة
تتناول صبا محمود حراك النساء في عددٍ من مساجد القاهرة بهدف تبيان قصور مفهومي الذات (subject) والفاعلية (agency) كما يحضران في المنظومة العلمانية-الليبرالية الغربية. تنبني هذه المنظومة على افتراضات محددة حول الحياة الحديثة وتشظي فضاءاتها، وبالتالي نجد سيادة مفهومي المقاومة (resistance) والاستقلال (autonomy) على أي طرحٍ يتناول تشكّل الذات في السياق الاجتماعي. بعبارةٍ أخرى، في كنف هذه المنظومة، لا معنى لفاعلية الذات إلا بالمقاومة، جسديةً كانت أم معنوية.
ولأن صبا محمود تؤمن أن الفاعلية والذات أوسع من ذلك، تطمح في فصول الكتاب لمساءلة المنظومة عن طريق إثبات فاعلية المتدينات في مصر واستقلاليتهن وفقًا لتصورات مغايرة عن الأخلاق والتدين والتقوى. ولذا تجري الكاتبة بحثًا ميدانيًا تتقصى فيه دور الممارسات والطقوس الدينية في تعريفِ هؤلاء النسوة لذواتهن ومسلكهن، فضلًا عن وضع كل ذلك في السياق الاجتماعي-الاقتصادي. وللأسف، ظل طموح الكاتبة في إثبات فاعلية النساء عصيًا على التحقق.
ربما يحقق الكتاب غاياته عند جمهوره المستهدف الأصلي، أي المنتمون لعالم الأكاديميا الغارق في طوفان النظريات ما-بعد-البنيوية وما-بعد-الاستعمارية (أقول ذلك بناء على نوع استشهادات الكاتبة وإحالاتها النظرية، إضافة للغة الكتابة ومصطلحاتها). لكن وقتما خرج الكتاب عن ضيق أفق ذلك العالم، يصبح عرضة للعديد من الأسئلة حول حدود الطرح المجاليّ وحول نجاح الكاتبة في توجيه نقد فعلي للمنظومة العلمانية-الليبرالية.
انتهت الزبدة. حبة حبة. سأبدأ بمشاركتكم ردي على سؤال الصديق أحمد لما نزلت ستوري سناب حلطومية: "وش اللي حدك تقرأه؟" وهو في الحقيقة سؤال مهم ومشروع؛ لماذا أقرأ الكتاب أصلًا؟ ما حدني على قراءته أولًا هو الزخم المحيط به عند بعض اليساريين كلما انجاب طاري فشل النظريات غربية-المركز في تحليل الذات المتدينة بالمجتمع الحديث. بغض النظر عن موضوع الكتاب -أي كتاب-، إذا كان مرجعًا مشتركًا للعديد من قراءاتي، فلا أستطيع تجاهله. ويزداد إلحاح الأمر حين يرتبط الكتاب بالنقد المنهجي الذي من شأنه تسليط ضوء مغاير على ظواهر مألوفة.
وما حدني على قراءته ثانيًا هو استشعاري لفكرة التدين على مستوى الحياة اليومية، لا أقلًا بسبب نشأتي ووجودي في سياق اجتماعي يتشارك العديد من الممارسات المطروحة في الكتاب. ولذا، توكيد الكاتبة المستمر على قصور الإطار المعرفي الغربي (والنسوي تحديدًا) عن إدراك تعقيدات ما يرتبط بالدين والسياسة والعلمنة في الشرق الأوسط سببٌ كفيلٌ بإثارة اهتمامي في كيفية معالجتها للموضوع.
وما ضاعف خيبة الأمل هو ازدياد حماسي بعد قراءة مقدمتي الكتاب (مقدمة الطبعة الأولى ٢٠٠٥، ومقدمة طبعة ٢٠١٢)، إذ ذكرت الكاتبة انشغالها في المقام الرئيس بالممارسات العبادية الجسدية وبدورها في تشكيل الذوات، مشددةً على ضرورة إدخال العاطفة والأخلاق والمشاعر في أي تحليلٍ يتناول الممارسة التقية إذا ما أردنا الإلمام ببعدها السياسي. يأتي طرح الكاتبة هنا مغايرًا للأطروحات التي تركز على معنى الممارسات وفق منظور متأثر بالبروتستانتية، أي الأطروحات المنطلقة من اعتبار الدين حيّزًا خاصًا أو المبنية على علاقة محددة ما بين الممارسات والحياة الحديثة.
وقد بذلتْ الكاتبة جهدًا مضنيًا في التوصل لهذه الاستنتاجات (أو التساؤلات بالأحرى)، إذ أمضت عامين في جمع البيانات ميدانيًا والتقاء نساء ورجال منتمين لخلفيات معرفية واجتماعية متباينة. كل ذلك بغرض فهم حركة التقوى ضمن سياق حركة الصحوة الإسلامية في التسعينات، واعتبارها أساسًا يُمكّن النساء من إثبات فاعليتهن ضد كل تنظير يعتبرهنّ محض ذوات خاضعة للمنظومة الذكورية.
ويحسب للكاتبة أيضًا عرضها الظواهر المبحوثة من منظور تعددي، مازجة بين تصريحات النساء والرجال أنفسهم وبين الأبحاث التي تتناول الظواهر بشكل مباشر أو غير مباشر، ناهيكم عن تشديدها الواضح على أولوية العربية -فصحى ودارجة- في بحث العلاقة المتذبذبة بين الباطن (interiority) والظاهر (exteriority) خارج محدودية الترجمة/النقل. ذلك أن الفكرة السائدة في المنظومة العلمانية-الليبرالية هي كون الظاهر امتدادًا للباطن، بمعنى أن المعتقد يأتي سابقًا للممارسة، وهو ما تحاول الكاتبة تقويضه من خلال التحليل المفصل لحراك النساء وشرح توظيفهن للغة والممارسة في إصلاح أنفسهن. الكثير من المصطلحات المحيّرة، صح؟ هذه كانت تجربة قراءتي، عانوا زيما عانيت.
لا أود تلخيص الكتاب فصلًا فصلًا، ويكفيني من السطور السابقة التمثيل على كمية الأسئلة الواعدة المتضمنة فيه. مع ذلك، جاءت نتيجة القراءة معاكسةً لرغباتي، وما بدا للوهلة الأولى طرحًا واعدًا سرعان ما تحول إلى تنظيرات موغلة في التجريد. سآخذ مثالًا سريعًا ينطوي تحت النقد المنقوص الذي سأعود له لاحقًا: بدل إعادة تعريف الفاعلية وفق امتثال النساء في مساجد مصر لتصور معين للتدين والأخلاق وممارساتها، وجدتُ المفهوم قد صار ضبابيًا لحد انتفاء جدواه التحليلية. نعم، صحيح أن الكاتبة نجحت في توضيح الحاجة لفك ارتباط الفاعلية بمقاومة البنى السياسية، وذلك انطلاقًا من إيلاء المنظومة العلمانية-الليبرالية أهميةً كبرى لأشكال محددة من الذات الفاعلة المستقلة دون غيرها. بعبارة أخرى، برهنت الكاتبة بالفعل على أن المنظومة إيّاها لا تقرأ الفاعلية إلا ضمن توليفة المقاومة-الاستقلال، دون الأخذ بعين الاعتبار احتمالية وجود توليفات أخرى. ولكن "فاعلية" نساء المساجد في الكتاب ناجمة عن التزامهن بممارسات تكرس الأعراف والتقاليد، الأمر الذي ينسف جزءًا كبيرًا من أهمية المصطلح التحليلية. فالمفهوم قد اكتسب زخمه التحليلي في أدبيات العلوم الإنسانية بناء على افتراض أن القبول الظاهر بالظروف الراهنة لا ينبغي أن يعمينا عن أشكال المقاومة المستترة، الأمر الذي يستوجب على الباحث التنقيبَ عن فاعلية كامنة في التعاطي مع البنى. أما في حالة سياسة التقوى، حيث نتيجة الفاعلية هي إعادة إنتاج الوضع الراهن، فمن الجلي تحول الفاعلية لمفهوم موغل في ذاتيةٍ يستقل معناها عن البنى الاجتماعية والسياسية.
أخشى أن الإطالة في نقطة نظريةٍ كهذه ستنسيني ما هو أوضح. فلئلا أزيد الحلطمة على قلة سنع، سأقتصر على النقطتين اللتين ذكرتهما في الزبدة: محدودية الطرح المجالي، والنقد المنقوص.
أكثر فكرةٍ تكررت في الكتاب (وفي السطور السابقة) هي ادعاء الكاتبة بأنها ستطرح ما من شأنه مساءلة المفاهيم خارج إطار المنظومة العلمانية-الليبرالية. ربما نجحت في ذلك جزئيًا، أو على الأقل أقنعت القارئ بنجاحها عطفًا على تكرر الدعوى مرارًا. لكن ما غاب عن الكتاب برمته هو مساءلة "مجالية" الطرح ومنهجيته، أي مساءلة المقاربة الأنثروبولوجية التي تبنتها الكاتبة خلال الفصول المتعاقبة.
تنبهتُ للأمر بالمصادفة في فصل "شكر وتقدير"، حين شكرت الكاتبة زملاءها على دفعهم المستمر لها كي تفكر بشكل "أكثر كثافة" حول موضوعات الدين والجندر. ووجدته مرة ثانية في نهاية الفصل الأول حين تكلمت عن النسيج "المكثف" لمخبريها، ومرة ثالثة في الهامش رقم (٢) بنفس الفصل لما ذكرت استخدامها مقاربة "ملاحظة المشارك" (participant observation) في جمع البيانات وعملها الميداني.
إشكالي كامن في استخدام الكاتبة للوصف المكثف (thick description) وملاحظة المشارك باعتبارهما مقاربتين بديهيتين لا تحتاجان للمساءلة. معرفتي بهذين المصطلحين ناجمة عن اطلاعي على أدبيات أنثروبولوجية سابقة، وأدرك ما يكتنزانه من آفاق بحثية. لكن على أي أساس أفترضُ كونهما مقاربتين "موضوعيتين" فوق النقد والاستقصاء؟
لو أردتُ الاستقعاد بشكل جذري لقلتُ أن استخدام الكاتبة لهما ناجمٌ عن موقعيتها المجالية، أي انطلاقها من أولوية الأنثروبولوجيا بصفتها مجالًا معرفيًا، ولسطرت اعتراضاتي المتعددة على هذا النوع من الأطروحات. مفاد هذه الاعتراضات هو وجود ارتباط وثيق بين التشكيلات الخطابية للمجال المعرفي والإبستمولوجيا الغربية المتبلورة خلال النصف ألفية الأخيرة، أي تلك التي تفترض انقسام الحياة على طول موضوعات غير قابلة للتحليل إلا على ضوء منهجيات مجالية مصاغة مسبقًا. ويستتبع هذه الافتراض احتكارُ الإنتاج المعرفي ضمن مجالات ومنهجيات ومصطلحات محددة، مُقصِيَةً بالضرورة ما لا يتواءم معها.
لكن لا أرى ضرورة اللجوء لهذا الاستقعاد الجذري هنا، إذ لم تقم الكاتبة حتى بالخطوة الأبسط، ألا وهي نقد المقاربة الأنثروبولوجية نفسها. طبعًا كان بإمكانها تبني مقاربة بينية (interdisciplinary) وتقليل سهام النقد حول هذه النقطة، ولكنها لسوء حظها لم تتبناها. يعني، استخدام الكاتبة للوصف المكثف وملاحظة المشارك، وتبنيها منهج البحث الميداني الذي يستحضر النظريات الأكاديمية لتفسير الظواهر، وتحديدها للممارسات المشروعة ضمن مجالها، أليست كلها ضمن الإشكالية التي أرادت تقويضها؟ بعبارة أخرى، تُشكِل الكاتبة على الباحثين منهجية استخدامهم للمفاهيم، وهي محقة في ذلك، لكنها هي الأخرى لا تُسائل المنظومة التي ١) تولي مثل هذه المفاهيم أهمية تحليلية ٢) تحجّم مصادر المعرفة المشروعة ضمن منهجية مسبقة. نظرة سريعة لفصول الكتاب وهوامشه ومراجعه كفيلة بإثبات ذلك؛ تنتقد الكاتبة النتيجة دون نقد الأدوات المولِّدة لها.
أما النقطة الثانية فهي ما أسميتها -تأدبًا- نقدًا منقوصًا. أدرك طبعًا كمية التعليلات المذكورة خلال صفحات الكتاب، والتي بيَّنتْ فيها الكاتبة أسباب تسليطها الضوء على جوانب محددة دون أن يعني ذلك تهميشها للجوانب الأخرى. مع ذلك، لا أظن هذه التعليلات كافية لتفسير العديد من أوجه القصور.
منها مثلًا تهميش الكاتبة للعوامل البنيوية في تشكيل الفاعلية. برغم توضيحها مرارًا وتكرارًا أسباب تغليبها لممارسات حراك نساء المساجد كما يرينها هنّ، فتظل إشكالية التحليل اللابنيوي قائمة عطفًا على اعتبار "سياسة التقوى" المبحوثة قابلة للتعميم. لو انحصر الأمر في تحليل الحراك وحده، لاختلف الأمر بطبيعة الحال. أما أن نفترض قابلية تعميم التحليل وربط الحراك بسياقات أوسع، نكون هنا أقحمنا أنفسنا مباشرةً في العوامل البنيوية التي تغيب عن الطرح.
فلا شك باختلاف السياق السياسي-الاجتماعي لمدينة مثل القاهرة عن مدن مصرية أخرى، واختلافه بطبيعة الحال عن دول شرق أوسطية أخرى. وبالتالي فإن فاعلية حركة التقوى بممارساتها الجسدية وأسئلتها حول التدين في الفضاء العام ستتغير قطعًا وقتما تغير النطاق، وقتما تحول لدول تفرض أنماط معينة من التدين (مثل إيران) أو العلمنة (مثل... أمزح). فما بالكم لو وضعنا الأمر في سياق التواريخ المختلفة لمجتمعات الشرق الأوسط ودور حركات الإسلام السياسي فيها؟
تتفاقم صعوبة الأمر حين نستحضر أمرين إضافيين: أولًا، تقول الكاتبة -وهي محقة في ذلك- أن حركات التقوى ليست "عودة" للماضي بقدر ما هي نتاج استحضار حداثي لتراث مخترع، أي نتاج إعادة تعريف معاصرة للعلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. على ضوء هذا الزعم، يستحيل قراءة الممارسات الجسدية خارج نطاق الأسئلة التي يطرحها الواقع الراهن، إذ أن البحث عن أجوبتها في الماضي جزءٌ من هموم الحاضر وتصوراته لماهية "الأصالة" أو التقوى في الماضي. ولذا ترتسم هنا إشكاليتان. أولًا، كيف يمكن التوفيق بين هذه الخصوصية ومكانة حركة التقوى ضمن حركة صحوة إسلامية عامة؟ هل تمتلك كل الحركات الإسلامية الصحوية ذات التصور؟
وثانيًا: لأي مدى ينبني التحليل برمته على تمييز جوهراني ما بين الغرب الليبرالي والشرق أو الإسلام التقليدي؟ أولن يصبح السؤال الرئيسي للكتاب (أي مفهوم الفاعلية المبني على ممارسات جسدية تعيد إنتاج العادات والتقاليد) غير ذي صلة إلا ضمن أطر غربية ابتداءً؟ لحظة، خلني أعيد صياغة الإشكالية: هل هذه الأسئلة حول الممارسة الجسدية والفاعلية وتكريس القيم أسئلة ذات صلة بالحراك نفسه؟ أم أنها مفروضة من قبل اعتبارات إبستمولوجية "مستوردة"؟
كل هذا كوم، والعلاقة الإشكالية بين التنظير والتحليل في الكتاب كوم آخر. تبذل الكاتبة جهدها في نقد المنظومة العلمانية-الليبرالية، معرجةً على نظريات تشارلز تايلور وميشيل فوكو وجوديث بتلر وبيير بورديو وطلال أسد وغيرهم. كما أنها لا تدخر جهدًا في استخدام استبصاراتهم وقتما وجدت ناجعيتها، سواء تمثل ذلك في مفاهيم الأدائية أو الهابيتوس أو الأخلاق (عند أرسطو تحديدًا، وذلك من حيث كونها تربيةً للذات) أو تشكيلات الذات ضمن نظم السلطة، أو حتى إشكالية العلاقة بين الدين والعلمنة.
وهذا الجهد مفهوم إذا ما افترضنا غرق جمهور الكتاب الأكاديميين في هذا النوع من الأطروحات، إذ يستوجب دومًا على الباحث إثبات أهمية مقاربته من خلال توضيح موقعه من الإعراب في الفجوة الإدراكية الموجودة في أدبيات مجاله. لكن وقتما تجاهلنا هذا الجمهور والغرق، قد تبرز معضلة عويصة: تُشيّد الكاتبة هيكلها التنظيري باستخدام الأطروحات الأكاديمية وحدها، أي دون أن يكون لبحثها الميداني ولحركات التقوى أي دور سوى تعديل طرحٍٍ نظريٍّ هنا أو مساءلةِ مفهومٍ هناك. بعبارة أخرى، برغم مزاعم تقويض المنظومة العلمانية-الليبرالية وإقصائها المعرفي، تعيد الكاتبة إنتاج أسسها عبر الفصل بين النظرية والممارسة، أو بين من يحق له التعبير عن مفهومٍ قابل للتطبيق ومن يصبح موضوعَ التطبيق.
فما الذي تعنيه كل تحليلات حركة التقوى إذا لم تلعب دورًا في بنية نظرية مغايرة شكلًا واصطلاحًا؟ لستُ أدري. وبس والله.