فضيلة ألا تنشر مسودة
هل صارت الروايات الناقصة المتعارف عليه؟
إن نوع الكتابة الوحيد هو إعادة الكتابة
- إرنست همنغواي (كما يُقال)
تخيل أن تقرأ رواية يرد في إحدى صفحاتها أن جريمةً ما قد حدثت قبل ٢٣ عامًا، ثم بعد أربع صفحات يقول السارد أنه قد مضى على هذه الجريمة ١٨عامًا، أو روايةً مسرحها العراق يقول ساردها أن جاء يزورهم رجل مرتديًا عمامة بيضاء، ومن ثم يعرّف الرجل الغريب نفسه بـ "السيد جمال" (تلميح: يرتدي السادة عمائم سوداء)؛ ألن يساورك الشك بأن هذه النصوص لم تُراجع كما يجب؟ أنها كانت بحاجة للمزيد من المراجعة والتنقيح لتلافي مثل هذه الأخطاء البسيطة؟ هذا ما ساورني حينما قرأت رواية خريف البراءة لعباس بيضون، ورواية وحدها شجرة الرمان لسنان أنطون، وهما الروايتان اللتان أخذتُ منهما المثالين السابقين على التوالي. هنالك بالتأكيد احتمالية كون الخطأ في الحالتين جزءًا من لعبة سردية، لا سيما والروايتان محبوكتان في أغلب أجزائهما بشكلٍ مميز، سوى أن ذلك لم يتراءى لي حين قرأتُهما قبل بضع سنوات، وتلاشى من ذاكرتي كل ما يتعلق بهما إلا هذين "الخطأين".
وحين قرأت مؤخرًا رف اليوم وحفنةً أخرى من الروايات السعودية الجديدة لكتّاب جدد، حضرت هواجس مشابهة بجرعة زائدة من عواز النص. ثمة اختلال نابعٌ من عدم تحرير النص تحريرًا حقيقيًّا؛ شخصيات تُقدم بتفصيلٍ لا يتناسب مع حضورها في الأحداث، تكثيفٌ لغوي-شعري لا يواري عيوب العناصر الأخرى، وسردٌ ليس إلا امتدادًا لوجودية مؤلفه وفلسفاته الثاقبة المفروضة على النص. لكن هذه التدوينة ليست عن الرواية المحلية عمومًا، بل هي عن رف اليوم تحديدًا، خصوصًا على إثر القراءات الاحتفائية التي وقعتُ عليها في الصحف وگودريدز قبيل البدء فيها.
ففي حين تقول بعض هذه القراءات أن الرواية من أفضل ما قُرأ محليًا، أو أنها أجادت قراءة إنسان اليوم وواقعه، وجدت منذ صفحات الرواية الأولى سردًا واقعًا في إشكالات منطقية تقوض هاتين القراءتين. هنالك مثلًا الإشكالات التي يقع فيها السارد (من منظور الشخص الأول، منظور البطل الرئيسي) حين يُدلي بما لا يستقيم مع تموقعه في زمان ومكان محددين، أو الأوصاف المتذبذبة التي تثير تساؤلات عدة حول آلية عمل العالم الذي يجد البطل نفسه فيه وما إذا تُخيّلت هذه الآلية باتساقٍ حقيقي، أو التناقضات المحيرة التي تجعل القارئ يتساءل عما إذا كانت مقصودةً أم لا. لماذا تكون النافذة مهمةً إذا كان الجدار برمته زجاجيًّا؟ كيف نفهم استعمال الشخصية مفردةً تسمها لاحقًا بأنها مفردة بائدة؟ وكيف يمكن التوفيق بين حكومةٍ قادرة -احتماليًّا- على رؤية كل ما تراه الشخصية دون أن يسبب ذلك مشكلةً في فترات فقدانها الوعي المتكررة؟ وما الفجوة الزمنية التي تفصلنا كقراء عن زمن الرواية المحتوية تكنولوجيا متقدمة جدًا مقارنةً بنا، سوى أنها ما تزال تحتفظ بمنظومات قيمية ومصطلحات مألوفة جدًا لدينا؟
ليس من السهل بطبيعة الحال خلقُ عالمٍ مستقبلي دون الوقوع في إشكالات ناجمة عن محاولة تجاوز الحاضر بشكلٍ أو بآخر. طالما يستحيل تخيل هذا المستقبل إلا بالإحالة المستمرة إلى أبعاد الواقع الحاضر، سيظل المألوف مدخلًا رئيسيًا لغير المألوف. أدرك صعوبة تحقيق هذا التوازن من خلال تجربتي الشخصية نصف الفاشلة في حياكة قصة "عهدنة" القصيرة التي تتناول -بالمصادفة- ثيماتٍ يتقاطع بعضها مع عالم رف اليوم، وأيضًا من خلال تجربتي في قراءة معاني المدن الفاضلة والراذلة ومحاولة فهم علاقاتها بواقعها. ولذا لست غريبًا تمامًا عن الصعوبات التي تعتور كتابة عوالم مستقبلية مثل عالم رف اليوم ولا غريبًا عن قراءتها.
ما علينا، سأسوّق لنفسي لاحقًا. المهم هنا الإشارة لذلك التجاذب المستمر بين الواقع والمستقبل، أو على الأقل بين منطق الواقع ومنطق المستقبل المتجاوز للحاضر. كل من يجلس محاولًا كتابة عالم مستقبلي يدرك الأزمات التي ستواجهه في تبرير وشرح العديد من أبعاد العالم للقراء بغية جعل العالم مفهومًا. تزداد صعوبة الأمر كلما افترق العالم المشيّد عن عالمنا المألوف، لا سيما حينما يقرر الكاتب ألا يلجأ لأساليب الراوي العليم وما أشبه في معرض رسم التصورات. وفي حين ينجح الكثيرون في تشييد عالمٍ متماسكٍ للحد الذي يجعله معقولًا كمسرحٍ للحبكة، يقع الكثيرون في مغالطات تقوض من أسس عوالمهم وتجعلها قابعة تحت المجهر فلا تسمح للأحداث بتولي زمام الأمور بسلام.
تستوقفني مثل هذه المغالطات لسببين: أولًا، لأني أهوى الاستقعاد (❤️). وثانيًا، لأنها تخرجني من عالم الرواية مهما حاولت تجاهلها. لا أمتلك بطبيعة الحال تعريفًا محددًا للرواية لكي أنوّركم به هنا ولا تصورًا حصريًّا يمكن من خلاله إدخال بعض المؤلفات لجنة الروايات وإقصاء غيرها، ولكني أعتقد على الأقل أن إحدى سمات الرواية (مقارنة بغيرها من الأشكال الأدبية كالشعر والقصة القصيرة) هي قدرتها على إعادة تشكيل واقعٍ ما سرديًّا. تبني الرواية عالمها الخاص انعكاسًا لمدركات مؤلفيها لعوالمهم هم. إن أبسط ما أرجوه من أي رواية هو أن تنجح في جعلي أستشعر هذا العالم الخاص بغض النظر عن تطابقه مع أي واقع، وهو بلا شك نجاحٌ مبني على عملية مشتركة من خلق المعنى والتصورات المختلفة.
لا يهم هنا ما إذا كانت الرواية واقعية أم فانتازية أم سوريالية أم أي "يّة" أخرى، ولا يهم كذلك كونها تتبنى بعض التقنيات والحيل السردية دون غيرها. المهم أنها ستتضمن في النهاية سردية تُعيد تشكيل العالم بحيث يصبح الحديث عن عالم روايةٍ ما باستقلالٍ عن الواقع ممكنًا، وبحيث يصبح الاندماج معها ممكنًا أيضًا حتى مع كسرها قواعد المألوف لدينا.
فاصل استطرادي المفروض أنه سريع ولكنه ليس سريعًا
لا بد هنا من استطرادين. أولًا، أقول أن الحديث عن استقلال عالم الرواية ممكن، أي أنه ليس حتميًّا أو مفروضًا، من باب أن العملية ليست أحادية الاتجاه أو حصرية. فلو أخذنا رواية ١٩٨٤مثالًا، لوجدنا أننا قادرون على تخيل أبعاد الحياة في عالمها من خلال سير الأحداث وخواطر ونستون ومن ثم قراءتها كلها على ضوء تجاربنا وعيشنا. فلا حاجة لأن نلمّ مثلًا بآلية عمل نظام الاتحاد السوفيتي ونتائج الحرب العالمية الثانية لكي نفهم ثيمات الأخ الأكبر ودقيقتي الكراهية ووزارة الحقيقة؛ فهم الثيمات مناطٌ بفهم النص. ومع ذلك، فإن الإلمام بتلك التفاصيل يجعلنا في الحقيقة أقدر على تخيل السياقات (الواقعية) التي تَشَكَّلَ عالم الرواية في كنفها، الأمر الذي يعمّق مدركاتنا للرواية وللسياقات معًا. الفكرة بسيطة: نقرأ الرواية في سبيل فهم واقع، ونقرأ الواقع في سبيل فهم الرواية. ولكن هذه نقطة خارج نطاق هذه التدوينة وسأتناولها بشكل منفصل مستقبلًا. الشاهد من ذكرها هو أن لعالم الرواية استقلالية من نوعٍ ما، وهي كافية نظريًا لأن نتعاطى مع عالمها كما لو أنه قائمٌ بذاته.
ثمة بعدٌ وجيه لا بد من ذكره أيضًا. إن القول باستقلالية عالم الرواية نظريًا لا يعارض اعتبار الرواية إعادة تشكيل للعالم بُغية إحداث أثرٍ ما. فكرة بسيطة هي الأخرى صح؟ تكتبُ كل روايةٍ على ضوء غايةٍ (أو غاياتٍ) ما. على بساطة الفكرة، إلا أنها أساسٌ مهم في إدراك تاريخانية أي عمل أدبي. لا، لا يعني ذلك أن على الرواية أن تكون ثورية نضالية ويا روائيي العالم اتحدوا، ولا يعني أن عليها نقد الواقع برمته ومحاولة تقديم حلول لمشاكله، ولا يعني أن عليها أن تكون في طليعة أجندة صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية. يعني الأمر باختصار أن هنالك غاية من وراء إخراج الرواية من حيز عقل الكاتب إلى العالم، سواء كانت غاية مدقعة في الذات أم لم تكن، وسواء تحققت الغاية أم لم تتحقق. وهذه الغاية وما يحيط بها مدخلٌ لإدراك واقعٍ ما.
أما ما يتعلق بالاستطراد الثاني، والذي كتبتُ التدوينة من أجله أصلًا، فهو أن الاندماج في عالم الرواية يشترط بالنسبة لي حدًا أدنى من التكامل والسلاسة في السرد. أتخيل نفسي أقود سيارتي على طريق معبّد. طالما خلا الطريق من المطبات والحفريات والتقاطعات، يمكن للطريق ذاته أن ينزوي إلى الخلفية فينصب تركيزي على المعالم الموجودة حوله. ولكن بمجرد أن تكون هناك حفرة أو تحويلة أو منعطف غبي (وهي ثلاثة عصافير قرر مقاول الشارع الرئيسي عند بيتي رميها بحجر وحيد)، فلا أجد مهربًا من التركيز على الطريق أثناء القيادة خشية البنشر أو إلحاق ضرر آخر بسيارتي، وهو ما يعني أني لن أتمكن من ملاحظة الأمور حولي بشكلٍ جيد. وعلى الغرار نفسه، إذا كان السرد سلسًا ومتكاملًا، لن يكون من الصعب عليه التواري وإفساح المجال لبروز مختلف التقنيات والثيمات التي يحيكها سوية. أما لو امتلأ بالثغرات والحفر، حينها سيصبح بحد ذاته محط تركيزٍ، وقد يتضح ما يعتريه من خلل يهز تكامل الحياكة مهما بدت بهية.
أوكي انتهى الاستطراد
طيب، وش قصدك يا حسين؟ بوسعي الإجابة على السؤال بالمزيد من البرغرافات الثرثارية، ولكن سأختصر الموضوع قليلًا (وأعني قليلًا، لأنك على وشك قراءة المزيد من الثرثرات أصلًا) وأتطرق مباشرة إلى رف اليوم. هنالك الكثير من الثغرات السردية الناجمة -حسب زعمي- عن عدم مراجعة الرواية وتحريرها بشكلٍ حقيقي. هذا الزعم هياطي نوعًا ما، وأتفهم التهمة وأتقبلها بصدرٍ رحب. ممارسة شيءٍ ما فترة طويلة قد تعطي الفرد منظورًا يتجاوز بساطة الظاهر إلى تمييز العملية التي بها يتأتى الشيء. فمثلما يميز عبيد الجم (نعم أحب أمثلة الرياضة، إذا لم يكن ذلك واضحًا يلا صار كذلك) أولئك الذين للتو يبدؤون مشوارهم أو الذين لا يتقنون فورم التمارين، فكذلك يمكن للضليعين في الكتابة ملاحظة مواطن الضعف الناجمة عن التحرير المش حالك. هل أنا ضليع؟ لحد كبير، إيه.
أزيدكم من الشعر بيتًا. أزعم أن ما جعل مراجعة الرواية أمرًا هامشيًا ليس الاستعجال وحسب، بل هو أيضًا انكبابها بشكل فج على ما سأسميه وعظًا؛ ينطلق السرد في رف اليوم من قيمة وموقف أخلاقيين تجاه العالم، وكل ما يكتنفه عالم الرواية يُطوّع في سبيل التبشير بالقيمة وبالموقف. وبالتالي فإن الثغرات الموجودة في الرواية ناتجة جزئيًا عن محاولة إتقان الجانب الوعظي على حساب الجوانب الأخرى.
دعونا مؤقتًا من خرابيط موت المؤلف وترهات الأكاديميين. لا أدري كيف يمكن لقارئ أن يقرأ رف اليوم دون أن يجد السرد يميل لرسم صورة رومانسية عن الحياة "التقليدية" وقيم المجتمع "ما-قبل-الحديث"، فضلًا عن شيطنة العديد من أبعاد الحياة المعاصرة وما تحتويه من هيمنة للتكنولوجيا وغيرها. يتخلل هذا الأمر كل جوانب الرواية لغةً وثيماتٍ وسردًا. ولذا يمكنني من باب الاستنتاج الأولي قول أن هذا التقديس/الشيطنة أحد غايات الرواية، أي أن عالم الرواية بما فيه من إعادة تشكيلٍ لعالم بغية إحداث أثرٍ ما فيه (حتى لو كان مجرد إحداث أثر في نفس القارئ طبعًا) مؤلفٌ على ضوء هذه الغاية الوعظية. لا يهمني الآن الإدلاء برأيي حول ذلك. المهم أنها تحتويه.
ولو كان هذا المقصد الوعظي متكاملًا مع عالم الرواية، على غرار ما يمكن قراءته مثلًا في روايات مثل الببغاء الأجرب أو النظر إلى الماضي، حيث الجانب الوعظي يشكل جزءًا من النص أصلًا، لما شكّل بالضرورة خللًا جوهريًا، ولأمكن تحليله ونقده بمعزل نسبي عما يدور من أحداث. أستحضر هنا إمكانية مقارنة طرح هكسلي في رواياته الأولى مثل عالم جديد شجاع برواياته الأخيرة مثل جزيرة؛ هنالك تحول فكري هائل في التعاطي مع العالم الفاضل/الراذل على أكثر من مستوى، وبالتالي يمكن قراءة الروايتين قراءة فكرية على ضوء سيرة هكسلي الحياتية دون أن ينهش ذلك من تجربة قراءة الروايتين نفسهما. ولكن الوعظ في رف اليوم لم يكن كذلك، بل بدا بنظري كالحفرة التي طعجت جنط سيارتي فصرت مجبرًا على مراقبة الطريق؛ كل ما في الرواية خاضعٌ لمنطق التبشير بقيمة أخلاقية قبلية.
سآخذ مثالًا وجيزًا لتوضيح ما أعنيه، مثالًا يمكن صياغة تفرعاته ضمن سؤال: لمن تُحكى الرواية؟ ويلزم التنويه بأن السطور التالية تحتوي على حرق جزئي للرواية، فالذين يبرطمون حينما تنحرق الروايات عليهم يمكنهم التوقف إن شاؤوا. هم الخسرانون.
لمن تُحكى الرواية؟
نقرأ في ختام الفصل الأول أن بطل الرواية يُنهي أيامه بتسجيلات صوتية يراجع فيها ما جرى خلال يومه. لنقرأ السطور سوية (أمزح، قرأتها قبلكم):
وجدت نفسي نهاية هذا اليوم أسجل حديثي في هاتفي لأني كنت بحاجة ملحة للتحدث مع أي أحد. تخيلت أنني أتحدث إلى أحد ما يقف أمامي ويتجول معي كما كان يفعل منتج صديق.
ذكرت تاريخ اليوم والدقيقة في بداية التسجيل، وقد انتهيت الآن من قول ما أود، وسأغلق الجهاز لأحاول النوم وأنا أعلم جيدًا بأن النوم بعيد عني جدًا.
وبذا يتشكل في ذهن مثلي من القراء أن كل ما نقرؤه في فصول الرواية المختلفة ما هو إلا مجموعة من التسجيلات التي يأخذ البطل على عاتقه تسجيلها في نهاية بعض أيامه. ظاهريًا، ليست هنالك مشكلة في تبني هذا الأسلوب السردي، لا سيما وأنه يساعد في توثيق الحالات النفسية والأحداث للشخصية الرئيسية عن كثب، أي أنها تجعل القارئ أقرب للسرد وجوديًا. زين، أين المشكلة؟ هناك ثلاث على الأقل. أولًا، هنالك بعض جزئيات الرواية المسرودة إبّان حدوثها. بعبارةٍ أخرى، ليس هنالك فاصل زماني ومكاني بين وقوع الحديث وسرده، مما يعني استحالة أن تكون الجزئية مُسجلة في وقتٍ لاحق. فلنأخذ مشهد الختام، المشهد الذي ينتحر البطل فيه. نجد وصف المشهد كالتالي:
هل كان البطل يسجل وهو يموت؟ هل نجا ومن ثم أعاد سرد اللحظة في تسجيل منفصل؟ هل مات ونجا المسجّل فأمكن العثور عليه ونقل محتوياته نصًا؟ لا لحظة. هذه مشكلة ثانية: من جمع لنا نص الرواية؟ إذا مات البطل فعلًا، فثمة العديد من التساؤلات عن نجاة التسجيلات. لربما أرادت الكاتبة شيئًا شبيهًا بالحيلة السردية في رواية مارغريت آتوود الراذليّة حكاية الجارية، حيث أن فصول الرواية هي الأخرى تسجيلات صوتية للبطلة، سوى أننا نعرف في الفصل الأخير أن من جمع التسجيلات ورتبها هم أساتذة تاريخ مهتمون بحقبة جلعاد التي جرت فيها أحداث الرواية. ولكن هذا النوع من التبرير غائب عن رف اليوم على مختلف الأصعدة.
على سبيل المثال، لو أعدنا قراءة الاقتباس الأول، لوجدنا البطل يقول بأنه ذكر تاريخ اليوم والدقيقة بداية التسجيل. لكن لو نظرنا إلى بدايات فصول الرواية، نجدها بلا تاريخ أو توقيت، ونجدها عوضًا عن ذلك تحمل عناوين. ولذا حتى لو تغاضينا عن المشكلة الأولى في سرد ما لا يمكن تسجيله وإصرار الكاتبة على الالتزام بمنطق التسجيل من خلال امتناع الشخصية عن سرد ما حدث أثناء غيبوبته، ليس من السهل قول أن فصول الرواية نقل حرفي لما كان يدور في التسجيلات. لا شك وأن هنالك يدًا خارجية؛ هل البطل هو من عنون التسجيلات بنفسه؟ هل هو الذي اختار العناوين من قبيل "السلعة غير متوفرة" و "الإنسان المسلوب" و "اليد من الخلف" أم أنها جاءت بتدخل لاحق؟ وهل هو تدخلٌ ممن ينتمي لعالم الرواية أم هي إملاءات الكاتبة؟
المشكلة الثالثة والأخيرة في تبني أسلوب التسجيلات كامنةٌ في ماهية المُخاطَب. من نفس الاقتباس الأول، يقول البطل أنه يسجل عطفًا على احتياجه الحديث مع أي أحد. زين. إن كان الأمر محض رغبة في الحديث، فلماذا تتوجه نبرة السرد لقارئ وهمي خارج عالم الرواية ولا يعرف تفاصيله؟ في الصفحة الأولى من الرواية مثلًا نجد التالي:
وأنا كنت أود شراء منتج صديق من سن الخامسة والعشرين حتى الثلاثين، وأردته أن يكون ذكيًا وكوميديًا ولا يتدخل في شؤوني الخاصة. وهذا النوع من الأصدقاء لم ينزل منذ فترة، ويسمى منتج صديق نجمي، أي مكتمل النجوم، وذلك لا يحدث إلا إن علا الطلب على المنتج، وكانت قطع صيانته جيدة وقادرة على الاحتفاظ بالمنتج كما هو مهما طال زمن استعماله.
لمن يشرح البطل منتج الصديق النجمي؟ ولمن يقول أن نزول المنتج مبني على ازدياد الطلب عليه؟ لو كان يحادث نفسه لما احتاج لشرح هذه البديهيات كونه يعيشها. في العديد من الروايات الفاضلة أو الراذلة، حينما يتنبى السرد منظور الشخص الأول الذي يحاول تبيان فضائل أو رذائل عالمٍ ما (مثل التي سبق ذكرها النظر إلى الماضي لإدوارد بيلامي أو يوتوبيا لتوماس مور أو حتى الحمار الذهبي للوكيوس) قد نقع على انفصال مكاني أو زماني يبرر قص الأحداث والعالم الفاضل/الراذل لمن لا يعرفونه. مسافرٌ عاد من مكانٍ بعيد مثلًا، أو سفرًا عبر الزمن للمستقبل ثم العودة للحاضر. لكن لو جئت أدون يومياتي شخصيًا، لما احتجت لقول أني ذهبت اليوم للدوام بالسيارة، والسيارة آلة نستخدمها للتنقل، والدوام هو المكان الذي أبيع ساعات يومي فيه مقابل حفنة من المال (لحظة ربما أحتاج لإعادة صياغة الوصف...)، لأن هاته أبعاد أعيشها ولا أحتاج شرحها لأحد. ولذا، فيما يتعلق برواية رف اليوم، أميل للقول بأن البطل من البداية يخاطبنا نحن القراء الذين ننتمي للعالم "التقليدي" حسب وصف الرواية. ولذا لا يجد حرجًا من تحديد ووصف مواطن الاختلاف والافتراق بين عالمه المستقبلي وعالمنا؛ السرد موجه لنا ضمنيًا.
يخالفني صديقٌ قائلًا أن شرح العالم بهذا الشكل منطقي، إذ البطل نصف آلة ونصف إنسان، فضلًا عن كونه قد عاش زمنًا في العالم "التقليدي" وبالتالي فهو يستحضر هاته التمايزات عطفًا على إدراكه الجوهري للفرق بين العالمين. رغم محاولتي للاقتناع بذلك، أعتقد أنها ترقيعة غير مجدية لسببين: أولًا، هي لا تستقيم مع الغياب شبه التام لتفاصيل العالم المبني على هيمنة الآلة ووجود هذا النوع من الكائنات(؟)؛ وثانيًا، ليس واضحًا ما إذا كان السرد امتدادًأ للجوهر الإنساني فقط لدى البطل أم أنه متأثر كذلك بجوهره الآلي. فمن النصف الأول للرواية، قد يتهيأ للقارئ أن البطل ما يزال واقعًا تحت نير الآلة والعقاقير وغيرها، وهو الأمر الذي يبدأ بالتحول تدريجيًا حتى يتغلب الإنسان فيه. ولكن ذلك مضلل قليلًا على ضوء الجزئيات التي يقول فيها البطل بنفسه أنه غير متأكد ما إذا كان يقظًا أم في حلم، مصحصحًا أم مهلوسًا. ولكن هذا استطراد لتفنيد الترقيعة وليس مهمًا تقصي كل حيثياته هنا.
الكتابة بصفتها إعادة كتابة
لا أدري أين قرأت مرة أن المسودة الأولى هي المسودة الأسوأ. لكن منذ ذلك الحين وأنا أضع هذه الفكرة نصب عيني في كل مرة أكتب، سواء كتبتُ بحثًا أم مقالةً أم رسالة وتساب. والله ما أبالغ.
فلنعد قراءة بداية الجمل الثلاث أعلاه لتوضيح بعض الهواجس التي تراودني وتجبرني دومًا على مراجعة الكتابات. بدأتُ الجزئية بجملة قصيرةٍ نسبيًا، متبوعة بجملة أطول ذات فواصل، ومن ثم ختمتها بجملة قصيرة (أقصر من الأولى). هذا التنويع في طول الجملة نابعٌ من إيماني مثلًا أن على الكتابة -أيًا كانت- أن تكون موسيقية، أي أن تكون متفاوتة الطول والرتم والإيقاع بحيث أطرد الملل عن القارئ. ولذا حتى لو كان عندي شيءٌ أرد قوله، فإن كيفية قوله ليست منفكة عنه.
ولكن هذا الهاجس لم يراودني في المسودة الأولى حين كتبتها (تقرؤون حاليًّا المسودة رقم ٥)، بل استلزمني الأمر بضع محاولات لطرح الأفكار الرئيسية والفرعية أولًا ومن ثم ربطها بشكل متسق ومنطقي لحد ما. فلو نشرت مسودة المقالة الأولى بافتراض وضوح أفكاري و "طبيعية" كتابتي، لكنت ربما أنحشُّ الآن عند واحدٍ فاضي استقعادي من على شاكلتي لا شاغل له سوى التحلطم وتبيان مواطن الخلل التي يراها، لا سيما وأنها ستكون حينئذ واضحةً. لكنها الآن غير واضحة كثيرًا ولله الحمد، والفضل للمراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة.
في الطبعة التي عندي، تبدأ رف اليوم في الصفحة رقم ٥ وتنتهي في الصفحة ١٠٩؛ حاولت الرواية في هذا العديد القليل من الصفحات أن تحيك عالمًا يتطلب تعقيده أضعاف ما كُتب فعلًا. بغض النظر عن رأيي فيما هو مطروحٌ في النص نفسه، وبغض النظر عن موقفي من تفشي الخطاب الوعظي في الرواية عمومًا، أقول أن الثغرات المنطقية السردية فيها قابلة للتلافي تمامًا لو أن الرواية روجعت وحُررت بشكل حقيقي. تبدو الرواية بالشكل النهائي الذي ظهرت عليه محض مسودة بحاجة للمزيد من التفكير والكتابة وإعادة الكتابة من أجل موازنة عناصرها والتحقق من خدمة التقنيات الأدبية للنص. ولو حصل ذلك، ربما ستصدق تلك القراءات والمراجعات التي سارعت للاحتفاء بالرواية، بدل أن تبدو -كما هي الآن- محض استئناس بإمكانية كامنة في فصولها.





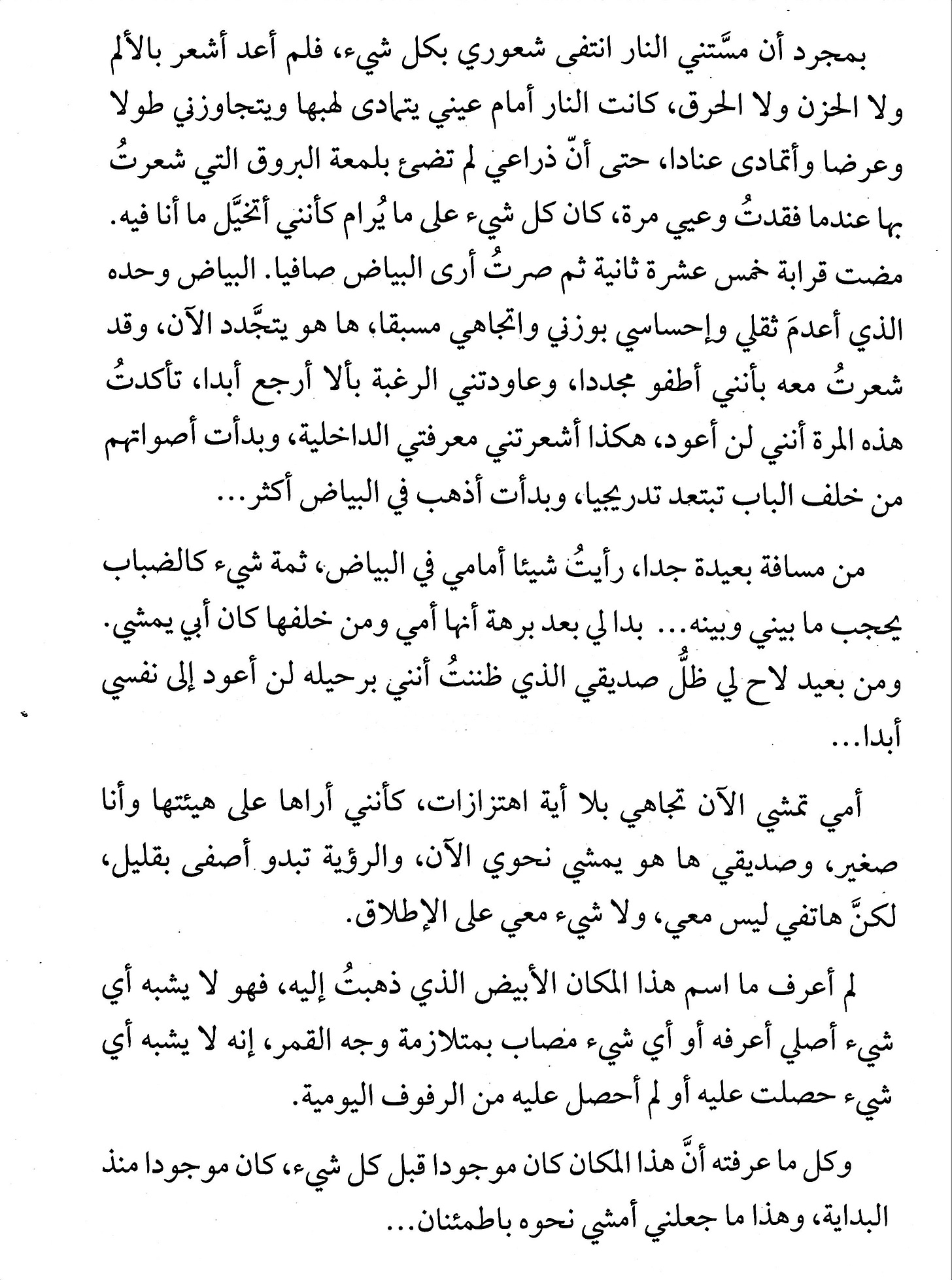
جميلة جدًا, حلطمة أكاديمية و مثرية