هل للرواية قيمة معرفية؟
أسئلة القراءة الملغومة
زعمي هو أن دارسي الثقافة، لا سيما في العصر الحديث الموغل في التسليع، يملكون فرصًا أقل لأن يكونوا ناقدين وناقدين لذواتهم إذا لم يطوروا قدرات معينة عبر تفاعلهم مع نتاجات ثقافية تمتلك هي الأخرى علائق نقدية أو تحويلية مع الثقافة المسلعة.
التاريخ والنقد - دومينيك لاكابرا
لو أعددت قائمة بالأسئلة الأكثر تكرارًا حول قراءة الأدب، لكان “هل للرواية قيمة معرفية؟” في طليعتها. ولو أعددت قائمة بأكثر الأسئلة سفسطة وسذاجة، لتبوأ نفس السؤال مركزًا متقدمًا فيها هي الأخرى. وهذا ليس مستغرب. يحمس السؤال للتفلسف حول العديد من الأمور التي تُعلي من قدرنا واهتماماتنا وتحط من قدر واهتمامات الآخرين. فأنصار الرواية مثلًا سيحلفون بالله أن من لا يقرؤها عديم الإحساس وضيق الخيال وفقير اللغة. وفي الجانب الآخر، سيستند مناهضوها -ممن يصنفون أنفسهم قراء المعرفة وللفلسفة- على زعم انتماء الرواية لكل ما يسبب ضمور التفكير؛ كلما انغمسنا في عالم السرد خرجنا من ملكوت العقل.
ولأني قد ضقت ذرعًا بالسؤال وتكراره، قررت وضع حدٍّ وإقامة الحجة على كل من يجد نفسه قباله. نعم، قرأتم ذلك بشكل صحيح: هذه الخربوشة هي كل ما تحتاجون إليه كيلا تعاودوا طرح السؤال وكيلا تفكروا فيه مجددًا. وإن شئتم، سأعيد عنونتها بما يتناسب مع مزاعمها: فصل المقال في فوائد قراءة أدب الخيال.
عمومًا، سأقسّم جواب الخربوشة لقسمين رئيسيين. القسم الأول موجه للمراهقين فكريًا والباحثين عن إجابة قطعية مباشرة للسؤال. هدف هذا القسم إعطاؤهم ذخيرة ومقدمات قابلة للاستخدام في إلجام الخصوم على تويتر أو غيره. فبما أنهم لا يسعون إلا لبلوغ لحظة “القمممممم”، فالمهم تعجيل وصولهم دون الحاجة لتشريح أي شيء.
أما القسم الثاني فهو موجه لأولئك العازمين على أخذ خطوة للوراء وإعادة التأمل فيما إذا كان السؤال ذا معنى ابتداء. بعبارة أخرى، هدف القسم الثاني مساءلة السؤال ذاته قبل محاولة الإجابة عليه. يحظى المخاطبون بالقسم بما يكفي من الحذاقة لئلا يأخذوا الأمور على ظاهرها، وبالتالي لا يمانعون التروي وتمحيص رؤاهم في سبيل تجنب الوقوع في مزالق الاجترار.
دون إطالة أكثر، لندخل المعمعة.
أنا مراهق فكريًا، فهل للرواية قيمة معرفية؟
هل صدقتم أني بعد كل هذا التقريع سأضيع وقتي لأغذي سفسطة النقاش حول سؤال ملغوم؟ أيًا كانت الإجابة، فلا يمكن تجاهل تكريسها أسسًا مغلوطة وتصورات ساذجة عن كل ما تشتمل عليه مفاهيم السؤال. ولم أكتب الخربوشة وأسجل حلقة بودكاست كاملة عن الموضوع إلا لأجل تناول هذه الأسس والتصورات. فإذا كنتم لسه عالقين بمرحلة المراهقة الفكرية باحثين عن إجابة قطعية، فالله يوفقكم في مسعاكم بعيدًا عن هذه السطور.
زين يالمو مراهق فكريًا، وش تمبى الحين؟
اللي أمباه أولًا هو إيصال فكرة أن رفض السؤال من أساسه مشروع. مو لازم نجيب على الأسئلة كما تطرح، وعادي تمامًا أن نتأنى ونتأكد من قبولنا الافتراضات الكامنة فيها. اعتبروا “هل للرواية قيمة معرفية؟” مثل سؤال: “بتصوم ولا زي كل سنة؟” أو “للحين تشدّب ولا هونت؟” بما أن السؤال يقرر حدود الإجابات المحتملة، فلا ضير من تمحيصه قبل أي خطوة إضافية. وهذا ما سأحاول فعله هنا بواسطة تناول كل مفردة في السؤال على حدة:
“هل”
أستفتح التمحيص بالمفردة الاستفهامية لأنها تحكر الإجابة ابتداءً على خيارين فقط؛ أيًا كانت التبريرات اللاحقة، فهي مسبوقةٌ باستفهام يجبر المجيب على النعم أو اللا. وهذا النمط الاستفهامي بطبيعته يرسم حدًا قطعيًا؛ يا أبيض، يا أسود. المنطقة الرمادية دي تبقى خالتك (وهي الخالة التي سأتناولها أدناه).
خلني أعيد صياغة الفكرة. الافتراض الكامن في “هل” هو إما صدق القضية المطروحة من عدمها. وهذا على خلاف مفردات استفهامية أخرى بافتراضاتها المغايرة. ماذا لو صغت السؤال كالتالي:
1. أين تكمن قيمة الرواية المعرفية؟
2. ما القيمة المعرفية للرواية؟
3. متى صار للرواية قيمة معرفية؟
4. لماذا لا تمتلك الرواية قيمة معرفية؟
كل استفهام يمتلك بالضرورة افتراضاته الخاصة. فالأسئلة الثلاثة الأولى تفترض مثلًا أن المعرفة في الرواية أمر مفروغ منه، بحيث يتركز السؤال على مواطن كمونها أو ماهيتها أو تاريخها. وبشكل مشابه، يفترض السؤال الرابع افتقار الرواية للمعرفة، محاولًا تعليل ذلك.
تعرفون أكيد تلك المقولة التي يرددها البعض بألا وجود لسؤال خاطئ. أتمنى لو كانت الأمور بهذه البساطة. كل سؤال قائم على افتراضات معينة، ولا شك أن إثبات مغلوطيتها يفضي لإبطال معنى السؤال ولو جزئيًا.
“الرواية”
يكمن الخلل هنا في استخدام (أل) التعريف على مفهومٍ مفرد. من قال أن هناك رواية؟ يعني، أكيد أن استخدام المفردة على سبيل الوصف استخدام طبيعي؛ هذا الكتاب ينتمي لصنفٍ تعاهد الناس على تسميته بالرواية، في حين ينتمي ذاك الكتاب لصنف آخر.
لكن استخدام سؤال عنوان الخربوشة للرواية ليس استخدامًا وصفيًا، بل استخدامًا تعريفيًا يمازج ما بين شكل وجوهر. بعبارة أخرى، تحضر الرواية هنا بصفتها تصورًا إقصائيًا يمايز ما بينها وبين أشكال تعبيرية أخرى، كالشعر والفلسفة والموسيقى وغيرها. وفي الوقت نفسه، استخدام (أل) التعريف يعني اختزال كل تعددٍّ مُحتمل. إذا ذهبتم المرة القادمة لمكتبة جرير، ستجدون قسمًا كاملًا مبوبًا بـ”القصة والرواية”. الرواية هنا اسم جامع لأجناس أدبية متعددة ومتداخلة كذلك. هناك روايات واقعية وروايات تاريخية وروايات خيال علمي وروايات فانتازيا وروايات تغريدات تويتر.
وأزيدكم من الرواية فصلًا. بإمكاننا اعتبار التبويب هذا منطقيًا قياسًا على تصنيفات أجناس الأدب المعتادة. لكن هل يعني ذلك أن الأجناس تحتكر الروايات المندرجة تحتها؟ كيف لو أخذنا بعين الاعتبار منطلقات أخرى، كالتقسيمات التقنية أو الثيماتية أو حتى الآيديولوجية؟ كيف نتعامل مع روايةٍ مثل صورة الفنان في شبابه، والتي تمازج ما بين منظور الشخص الثالث المحدود وتيار الوعي (تقنية)، وتدور حول هوية شاب ضد عادات مجتمعه الذي ما عاد يستسيغه (ثيمة)، مقولبة إياها في منظور حداثي (آيديولوجيا)؟ أكيد أننا لن نتلقاها كما نتلقى روايات تافهة مثل أولاد حارتنا أو غيرها من روايات نجيب محفوظ.
لن أقول طبعًا أن مساءلة أسس الأجناس الروائية ضروري من باب امتلاك بعضها قيمة معرفية دون الآخر، كلا. هذا نقاش محبب للمراهقين فكريًا الذين يتحينون الفرصة للمنافحة ضد مناهضي الروايات قائلين: “خطأ! الرواية التاريخية تزودنا بالمعلومات!” ما سأقوله عوضًا عن ذلك هو أن رفض التصور الجوهراني خطوة لا مناص منها في طريق التحرر من المألوف وبدء تعقيد الموضوع حبتين زيادة.
الرواية بالتصور الوصفي مختلفة عن نظيرتها بالتصور التعريفي الإقصائي، وينبغي ألا نسمح للتبويبات والتقسيمات أن تصبح أساس قناعاتنا. ومن الضروري التنويه على أن هناك اقترانًا بين التصنيف وحكم القيمة، وهو نابعٌ عن تقليد قديم في عملية إنتاج المعرفة، حيث يقضي الباحث وقتًا طويلًا في التصنيف والتبويب ليسهل عليه إطلاق حكم القيمة في وقت قصير. فكأنما كل ما عليه هو تشكيل قاعدة بيانات بحيث تكون العمليات المستقبلية محض مقارنة وقياس.
خلني أعيد صياغة الفكرة: استقرار الباحث على تصنيفٍ للعمل يعني وصوله للنتيجة النهائية، وهي نتيجة حكم “قيمة” بكل تأكيد، قيمة عليا أو دنيا بحسب مدخلاته. وبالتالي يلعب التصنيف دورًا محوريًا ويصير وركيزة أساسية عبرهما يصل الباحث إلى حكم القيمة ويراكم قاعدة بياناته في الوقت نفسه.
لا يهتم هذا القارئ بالعملية الإبداعية لكل نص بقدر اهتمامه بإيلاء المكانة للنصوص وكتّابها. ويسهل تمييزه من بين الألوف المألفة لأن نقاشاته المعرفية محصورة على الأحكام الفضفاضة: “هذا أفضل، لكن هذا أرصن، وذاك أوعى، وهذا أتقن، وذاك أذكى”. لا مناقشة للأفكار ولا توليد للمعاني، وكأن النصوص أو المعرفة “تكتيك” غرضه الوصول إلى مكانةٍ ما.
وهذا ينقلنا إلى المفردة التالية.
“القيمة”
تنويه: تحتوي السطور القادمة على ما لا يليق بعبيد الرأسمالية ومن والاهم.
لوهلة أولى، قد يبدو استخدام “قيمة” ترجمةً لـvalue بلا مشاكل، وهذا الدارج أصلًا. ولكن مجددًا، أتمنى لو كانت الأمور بهذه البساطة. لو تقصينا انزياحات معاني value (ولا حاجة هنا للعودة إلى أصولها الفرنسية valoir أو اللاتينية valēre) لوجدنا أنها بدأت تكتسب وتفقد بعض معانيها خلال نصف الألفية الأخيرة تزامنًا مع صعود نظام استغلالي تسليعي استخراجي. في هذا السياق، ارتبطت القيمة بالنظام لتضم معانٍ أخرى، مثل قيمة الانتفاع وقيمة التبادل والقيمة المضافة، فضلًا عن تسربها لنواحٍ أخرى متعلقة بالأخلاق والمجتمعات والثقافة.
حين نتساءل عن قيمة الرواية المعرفية، فنحن نتعامل معها كما لو أنها خاصية كامنة في الرواية، كما لو أنها شيء ينبغي علينا تحصيله واستخراجه والانتفاع به. هذا من أعراض العقل الرأسمالي الذي يسعى دائمًا لقياس القيمة وتكميمها عبر منطق العائدات والاستثمارات. حين نتساءل عن قيمة الرواية المعرفية بلا إشكال، فنحن نتجاهل كون “القيمة” في هذا السياق مفهومًا حديثًا مرتبطًا باصطلاحات وآليات السوق.
ومن جانب آخر، عودًا على النقطة أعلاه حول التكتيك الموصل للمكانة، يكون سؤال القيمة المعرفية أحيانًا مجرد التفاف حول سؤال القيمة الاجتماعية ورأس المال الرمزي، لأن القيمة المعرفية المقصودة هنا تكون أحيانًا المعرفة القابلة للاستخدام في الديوانيات والندوات وهوس الإمساك بالمايك (عشان يصوروه ويحطها صورة بروفايل في الفيسبوك).
شطحة قصيرة: يتحسر أحد الروائيين العرب الذين يبدأ اسمهم بحرف النون وينتهي بـ جيب محفوظ عن بدايته المتأخرة في دراسة الأدب، قائلًا أن ضيق الوقت أجبره على ألا يعاود قراءة أي كتاب مرتين خشية فقدان فرصة تختيم كتب أخرى. هذا عرض آخر من أعراض النزعة الاستهلاكية التي تكرس مفهومًا تحصيليًا للمعرفة.
لا يعني ذلك طبعًا بطلان الجدوى التحليلية لمصطلح “قيمة”. بالإمكان استشفاف قيمة أدبية من رواية، أو قيمة فلسفية، أو قيمة تاريخية. ومن البديهي أن تبدو القيمة كامنة -ولو جزئيًا- في الرواية. لكن هذه النسبية هي ما أود الإشارة إليه هنا، وذلك نظرًا لعلاقتها المباشرة بالذات وبدوافع القارئ.
وما الحل لإحراز ذلك؟ متابعة قراءة الخربوشة، والرد أيضًا على السائل بعبارة بسيطة: عساها الرواية مالها قيمة، وشدخلك؟
“المعرفة”
وهذا ما يجرني لآخر فقرات تمحيصي: مفهوم المعرفة. يستبطن سؤال “هل للرواية قيمة معرفية؟” ما يمكن وصفه بالمفهوم التحصيلي للمعرفة (أتمنى ألا تتسبب مفردة التحصيلي في تهييج أي PTSD). بهذا المعنى، المعرفة “شيء” مستقل عن ذواتنا، ولاحتيازها ينبغي علينا نهلها من مصدرٍ ما. بعبارة أخرى، تكون المعرفة كامنة في الشيء، ويقتضي تحصيلها انتقالها من الشيء لنا. إذا قرأتُ روايات دوستويفسكي، سأعرف كيفية سبر أغوار النفس البشرية. إذا قرأت ثلاثية غرناطة، سأجدني كمن يرتدي قفطانًا ويتجول في أسواق الأندلس لشراء اللوز المحمص بالعسل. كلا التصورين نتيجة مفهوم استهلاكي بدون لف ودوران. ليش؟ لأنهما يأخذان بما يقوله النص دون مساءلة سياقات إنتاجه وتوظيفه للمفاهيم.
طبعًا بالنسبة لمناهضي الروايات، طالما خلت الرواية مما هو قابل للتحصيل بهذا المعنى، تصبح إجابة السؤال نفيًا قاطعًا بامتلاك الرواية أي معرفة. وبالعكس، قد يستثنون الروايات التاريخية أو التوثيقية وذلك لأنها تعطينا معلومات.
ولكن لسوء حظ بعضكم، مفهوم المعرفة هذا من أعراض المراهقة الفكرية هو الآخر. عرفتم لماذا يطير البعض إعجابًا بالمثقف الموسوعي القادر على سدح أسماء المفكرين وصفصفة المصطلحات؟ لأنهم غارقون في غياهب المفهوم التحصيلي إياه، ومحدودون بإطار يعامل المعرفة كأنها سلعة حالها حال غيرها من السلع. فلو وجدتم بعض هذه الصفات تنطبق عليكم، أنا آسف لكم، بس المفروض أن كلمة الحق ما تزعل.
أطمئنكم أن الخروج من هذه المراهقة ممكن بسهولة. فلنشح البصر مؤقتًا عن المفهوم التحصيلي ونتأمل في إمكانية كون المعرفة توليدية، أي في إمكانية كونها بالضرورة نتاج تفاعل بين ذاتين. المعرفة هنا نتاج عملية تأمل، لا تحصيل. المعرفة علاقة بين الذوات، لا سلعة متداولة بينهم. والأهم من كل ذلك، المعرفة قابلة لتغيير الذات، لا مجرد إثرائها.
توليد المعرفة من الروايات يعني استنطاقها، كلٌّ بحسب زاويته. التساؤل عما دفع المؤلف لتبني أسلوب معين يولد معرفةً حول التقنية. التساؤل حول سياقات إنتاج النص يولد معرفة تاريخية-اجتماعية. التساؤل حول انتشار العمل يولد معرفة ثقافية. وش تبغون بعد؟ التساؤل حول لغة كتابة العمل يولد معرفة خطابية. التساؤل حول ثيمات العمل يولد معرفة سياقية. بل حتى التساؤل حول تلقي العمل قابل لتوليد معرفة سياسية.
وعلى صعيد آخر، لا ينبغي طرح سؤال الفائدة المعرفية بحسب ما نستطيع إظهاره للآخرين، بل بحسب ما يولده القارئ بينه وبين ذاته (ما ذبحتونا بسالفة أن القراءة فعل ذاتي؟)، كذلك توليد المعرفة عملية ذاتية تنتج من خلال المساءلة أو الالتحام مع النص، والحجاج في بيئة ذاتية مغلقة. ظهور نتائج التوليد المعرفي أمر لاحق على هذه العملية الصادقة.
إذن، بدل طرح سؤال ما إذا كانت الرواية تمتلك قيمة معرفية، حري بنا التساؤل عما إذا كنا قادرين أصلًا على توليد المعرفة عوض تحصيلها واجترارها، وهذا ما من شأنه تسليط الضوء على ذواتنا ودوافعها من وراء القراءة أو أي ممارسة أخرى.
إضافة أخيرة: قد يتنبه قارئ مستقعد لتجاهلي التام لسؤال العلاقة بين المعرفة واللغة، من حيث أن كل رواية ليست في نهاية الأمر سوى نص يستخدم اللغة في إعادة تشكيل العالم، سواء عن طريق المحاكاة أو التخييل أو النقد أو غيرها. ولكن تناول اللعنة النصية وعواقب افتراض نظم لغة مغلقة موضوع خربوشة أخرى.




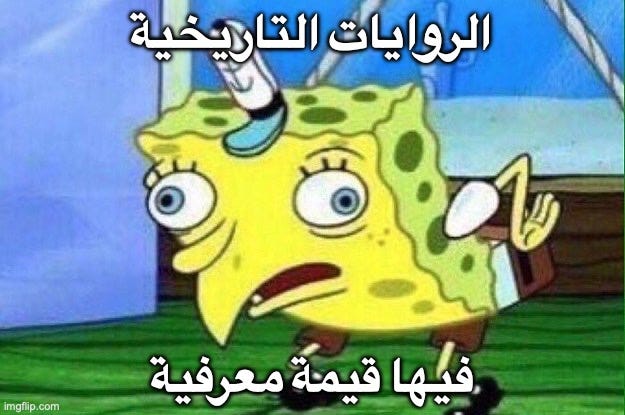

شكرا لك على رفع مستوى التحليل وأسلوبك جد ممتاز