جذور رداءة الرواية العربية
قراءة بديلة لموسم الهجرة إلى الشمال
لو بحثتم في الشيخ غوغل عن أفضل الروايات العربية "على الإطلاق"، لوجدتم موسم الهجرة إلى الشمال تتبوأ مقعد صدارةٍ بها. وستجدونها بسهولة أيضًا في قائمة أشهر الروايات العالمية والعربية التي "تستحق القراءة"، أو قائمة أفضل ١٠٠ رواية في القرن العشرين وفق اتحاد الكتاب العرب.
ولو وسعنا نطاق البحث قليلًا ليضم عالم الأكاديميا، عالم إنتاج المعرفة الحقيقي كما يؤمن الكثيرون، لعثرنا على الرواية أيضًا تدرس في مساق "أسس ثقافة العالم" المندرج تحت قسم الأدب بجامعة MIT، أو في مساق "الإسلام والشرق الأوسط والغرب" المندرج تحت قسم التاريخ بنفس الجامعة. كما تُقرأ الرواية في مساقات تنتمي لأقسام علوم السياسة والأنثروبولوجيا وعلم اللاهوت والاقتصاد في جامعات تترامى ما بين أمريكا وفرنسا وجنوب أفريقيا والهند وألمانيا والمملكة المتحدة. هنا المصدر، لا تصيحون.
وبإمكاني تقصي بعض ما تعلق بالرواية زيادة، مثل كونها سببًا في وصف كاتبها الطيب صالح بعبقري الرواية العربية، أو كونها تُقرأ نقديًا إلى جوار سارتر وفانون ودانييل دافو، أو اعتبار صيغتها السردية تجليًا لسياقات المشهد الذي نشأ فيه النص بما فيه من عنف واغتراب وهويات استعمارية ومدري وشو. فمثلما تعرفون، قد يكون النقد الأدبي فضفاضًا بالدرجة التي تجعل أيًّا من إسقاطاته وتفسيراته مبررة طالما رافقها تدليل من النص. تمامًا كهذه الخربوشة.
ما علينا. الشاهد أن سمعة الرواية وكاتبها تجاوزت الآفاق والحدود بحيث تعد اليوم رمزًا أدبيًا لا يمس. انطبع كل ذلك على ذهني طوال السنين الماضية التي سوّفت قراءة الرواية فيها. سمعت عنها للمرة الأولى قبل عشرة أعوام تقريبًا، على أعقاب تلك الصدمة إياها. سعيت وقتها للإحاطة بأروع الروايات العربية وأشهرها، وقد وقعت على موسم الهجرة إلى الشمال في معرض قراءتي عن الأدب ما-بعد-الكولونيالي. وتهيّبت منذ حينها؛ فقبال مثل هذه الروايات العظيمة زعمًا، من أنا لأقرأها دونما استعداد فكري وذائقاتي لإدراك ما تنطوي عليه الرواية قلبًا وقالبًا؟ أكيد أنها تحتاج عقلًا متفتحًا وقادرًا على إدراكها على الطاير، وهو الأمر الذي اعتقدتني مفتقره آنذاك.
ولكن شاء الله أن أقرأ الرواية أخيرًا ضمن سلسلة يلا نقرأ في بودكاست كتبيولوجي، السلسلة التي انطلقت قبل بضعة أشهر. قرأتها بعدما تسلحت بفكر ما-بعد-الكولونيالية وألممت بآخر صيحات النقد الأدبي وفهمت تاريخ الاستعمار بعض الشيء. ولذا بدأت الرواية متحمسًا، وكلي أمل بأنها ستزلزل عالمي زلزلة ما سبقتني بها رواية من العالمين.
قرأت صفحة، صفحتين، خمس صفحات، عشر صفحات. لحظة، وشو قاعد أقرأ؟ ما هذه السخافة؟ عشرون صفحة، أربعون، تعديت نصفها. لا لا أكيد أن هنالك ما سيغير رأيي نهايتها، مستحيل أن الرواية بهذا السوء. مئة وخمسون صفحة، مئتا صفحة. "النجدة. النجدة". بس؟ أستغفر الله العلي العظيم. لا أبوكم لا أبو هالسرد البايخ ولا أبو هالمصطفى سعيد اللي مسوي فيها غامض وكول.
ولأن حنقي يتناسب طرديًا مع مقدار التبجيل والتقديس والتطبيل الذي يطال المؤلفات، آليت على نفسي ألا ينتهي يومي دون تقيؤ بعض هذا الحنق على كيبوردي المسكين. أنهيت الرواية قبل بضع ساعات (أعني حين بدأت كتابة الخربوشة، ولكنكم ستقرؤونها من بعد تاريخ ١٠ سبتمبر بكل الأحوال)، ولذا كل ما سأقوله هنا مبني على انطباعٍ أول طازج تمامًا. بطبيعة الحال، يجوز أن أعود للرواية بعد فترة فأجد بعض ما غاب عني، لا سيما ما يتعلق بثيماتها. لكن فضلت قولبة انطباعي هنا قياسًا على تجربة قراءة محبطة كليًا، ولئلا أضيع وقتي وحيدًا.
شكل خارج السيطرة
تعرفوني محبًا للثرثرة والاستطراد، واستعجالي التحلطم حول الرواية لن يعفي الخربوشة من ذلك. أجدني أنحو تجاه الاستطراد التنويهي من بابين مترابطين: باب الشكل الأدبي، وباب الأهمية التاريخية. ينبني انطباعي هنا بشكل رئيس على الشكل الذي عولجت من خلاله ثيمات العمل، وثمة ضرورة للتمييز بين الشكل والثيمة ولو إجرائيًا. كتبت خربوشة سابقة تطرقت فيها لبعض قناعاتي حول العلاقة بين الشكل الروائي وإعادة تشكيل العالم وتكاملهما في خلق تجربة قراءة انغماسية، وأظنها كافية لتوضيح بعض ما أعنيه. ولا أنوي الزيادة عليها كثيرًا هنا إلا لقول أن ركاكة الرواية "أدبيًا" لا يعني تفنيد أهميتها "تاريخيًا".
أضع المفردتين بين علامات تنصيص للتذكير بالفصل الإجرائي (الاعتباطي ربما) بين الاثنين، بين الشكل والموضوع، سوى أنه يظل بالرغم من ذلك فصلًا مهمًا. نعم، أعرف أن الرواية نشرت للمرة الأولى عام ١٩٦٦، أي بعد عشرة أعوام تقريبًا على استقلال السودان من الاستعمار البريطاني، وبالتالي أعرف أن الرواية تعالج بعض جوانب الاستعمار "المستتر". أعرف أن عنف حسنة مواز لعنف مصطفى سعيد، وأن طعنها لود الريس يُفهم على ضوء طعن مصطفى لجين موريس. أدرك أن هنالك تصويرًا لثنائية الشرق والغرب بشكلٍ ما، أو لثنائيتي الحداثة/التقليد والتعليم/التخلف تحديدًا. وأدرك لحد بعيد محورية الجنس في فهم شخصيتي السارد ومصطفى سعيد، كما أعرف أهمية تناول تداخل قصتهما وكيفيتها. وأعرف أن سنة ميلاد مصطفى سعيد (١٨٩٨) تمثل ابتداء حكم الاستعمار البريطاني للسودان بشكلٍ ما، وبالتالي يصبح من الضروري تخيل تبلور شخصيته في سياق ذلك الاستعمار والحرب العالمية الأولى وما تلاها. أعرف كل هذه الأمور، تراني لست بتلك العباطة.
لكن كل ثيمة من هاته الثيمات المذكورة مستقلة نسبيًا عن الشكل الذي عولجت من خلاله، أي الشكل الروائي، وهنا بيت القصيد؛ طالما اختار الطيب صالح الشكل الروائي لمعالجة مختلف الثيمات وربطها في حبكةٍ ما، فهنالك عناصر من شأنها الرفع من "أدبية" العمل أو الحطّ منها بمعزل عن الثيمات ومعانيها في السياق التاريخي الأوسع. فمن باب أول، قد تتطرق الرواية لثيمة ما، ولكن نفس الثيمة قابلة للمعالجة على يد الشعر أو السينما أو الفن، كل وفق تقنياته ورؤاه. ومن باب ثان، قد تعالج روايتان الثيمات نفسها، ولكن ذلك لا يعني أنهما سواسيتان، إذ لكل واحدة منهما أساليبها وتقنياتها الخاصة في قولبة الثيمات ضمن حبكة ما.
وكيلا أفهم خطأ، لست أحتكم هنا لمعايير موضوعية مطلقة، ولا أقول أن على الرواية احتواء العناصر المعنية وإلا يتوجب نفيها عن الأدب. ما أقوله هو أن هنالك أسئلةً تدور بخلد القارئ بمجرد قراءته أي رواية، أسئلة حول زمانها، حول مكانها، حول منظورها السردي أو أسلوبه، حول بناء شخصياتها، حول ثيماتها وموضوعاتها وبلاغياتها، وغيرها مما يعتمل بذهن القارئ ويحيي النص الذي بين يديه. الرواية الناجحة بالنسبة لي هي الرواية القادرة على توظيف مختلف التقنيات والثيمات والبلاغيات في سبيل إحداث أثرٍ ما بقارئها. وبذا تكون الرواية الفاشلة تلك التي حجب بينها وبين آثارها ثغرات سردية تفسد جزءًا من عملية خلق المعنى.
وهنا الإشكالية الكبرى بظني. قد يحدث أن ترتبط الرواية (أي رواية) بقارئها عاطفيًا، أو شعوريًا، أو فكريًا، قد يحدث أنها تصبح عزيزةً على قلبه لسببٍ أو لآخر، وأن تذكّره بما يحن إليه. لكن الحالة الوجدانية هذه لا تعني بأي شكل من الأشكال كون الرواية معيارًا لما يفترض على الروايات أن تكونه فنيًا أو شكليًا أو ما إلى ذلك. الأمران مختلفان، وخربوشتي كما تشير مقدمتها الطويلة موجهةٌ لأولئك الذين أخذوا على عاتقهم إما تكريسَ موسم الهجرة إلى الشمال في متن الرواية العربية، أو كرروا كالببغاوات أسباب تكريسها.
لا أنكر نجاح موسم الهجرة إلى الشمال بإحراز نجاح متمثل في حياكة ثيمات الاستعمار (وما بعده) بالتقابل بين حياتين مختلفين وتبعاتها على نفوس الأفراد. هذا النجاح الوحيد الذي أجده في الرواية حتى الآن. إن كانت هنالك إمكانيات نجاح أخرى، فقد احتجبت عني جراء فشل الشكل الروائي الذي تبناه الطيب صالح، الفشل الذي سأعزوه للإخفاق في الإلمام بالعناصر الأدبية وإحكام القبضة عليها.
وحدة النص وتشظيه
سأقتصر في هذه الخربوشة على نقطتين: على منظور/أسلوب السرد في علاقتهما بالزمن، وعلى تماهي الشخصيات. وبطبيعة الحال، بما أني أضعت ما يكفي من الوقت في إنهاء الرواية، وسأضيع المزيد منه في كتابة هذه الخربوشة، فسأقتصر في تناولي على أمثلة متفرقة وحسب. سأبدأ بالنقطة الأولى: منظور السرد وأسلوبه وعلاقتهما بالزمن. وربما يلزم التنويه على اعتمادي على طبعة دار الجيل الأولى عام ١٩٩٧ في إحالتي لرقم الصفحات.
تبدأ الرواية بجملتين افتتاحيتين مثيرتين للاهتمام:
عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، سبعة أعوام على وجه التحديد، كنت خلالها أتعلم في أوروبا. تعلمت الكثير، وغاب عني الكثير، لكن تلك قصة أخرى.
بمجرد قراءة الجملتين، سيدرك القارئ مخاطبة السارد للقراء، واعتزامه قصّ الأحداث عليهم. الجمل التي تليها تستخدم بشكل رئيسي صيغة الماضي، مما يؤكد على انطلاق السارد من نقطةٍ زمنية تلي بداية القصة كما اختار بدءها. يتأكد ذلك بما يرد في الصفحة الثامنة، حين يقول السارد:
نسيت مصطفى بعد ذلك، فقد بدأت أعيد صلتي بالناس والأشياء في القرية. كنت سعيدًا تلك الأيام، كطفل يرى وجهه في المرآة لأول مرة.
يقول أنه (كان) سعيدًا (تلك الأيام). واضح أنه يقص من نقطة زمنية لاحقة، صح؟ زين. في الصفحة التاسعة، أي الصفحة التي تليها، يتغير ضمير السرد فجأة للمضارع: "إنني أريد أن آخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر". هل ما زال السارد يقص قصته، أم أنه استطرد ليتحدث عن تطلعاته الحياتية بشكل عام؟ أكيد أنه استطرد، صح؟ ودليل ذلك قوله: "كنت أفكر، وأنا أرى الشاطئ يضيق في مكان ويتسع في مكان، إن ذلك شان الحياة، تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. لكن لعلني أدركت ذلك فيما بعد. أنا الآن، على أي حال، أدرك هذه الحكمة [...]"
وفق سيناريو الاستطراد هذا، يصبح استخدامه للماضي والمضارع تقنية تمايز ما بين زمن حدوث القصة وزمن روايتها، بحيث يشاركنا السارج تأملاته حول معاني الأحداث دون الخروج عن سلاسة السرد. حلو. ما شاء الله بدأنا بحيلة سردية حلوة. ها؟ لحظة، خلني أقرأ ما يأتي بعدها:
وأنظر إلى النهر بدأ ماؤه يربد بالطمي [...] وتمتلئ عيناي بالحقول المنبسطة [...] أسمع طائرًا يغرد أو كلبًا ينبح [...] وأحس بالاستقرار. أحس أنني مهم [...] وأذهب إلى جدي
لماذا يستخدم المضارع في توصيف المشهد المنتمي لزمن قصته؟ لو أنه يتأمل هنا فعلًا عامًا لما كان هناك أي إشكال. لكن ما يحدث هو أنه يقول "أذهب إلى جدي" ويذهب إليه فعلًا في قصته، ثم يعاود استخدام صيغة الماضي. امممم الأمر محيّر. طيب قد أكون فهمت الموضوع خطأ. خلني أكمل.
في الصفحة الثانية عشرة، بدأ الجزئية التي عقبت لقاء جده قائلًا: "بعد هذا بيومين، كنت وحدي أقرأ وقت القيلولة". أوكي السارد قرر القفز يومين، هذا يعيدني لفكرة كونه يقص من نقطة زمنية لاحقة. وقد كرر قفزة أخرى طولها شهرين في الصفحة الثامنة عشرة، وقفزة أسبوع إضافي في الصفحة التي تليها. يعني تزداد احتمالية كونه يقص قصة قد حدثت بالفعل، الأمر الذي يُمكّنه من تخطي الأحداث غير المهمة بالنسبة إليه. وما تزال صيغة الماضي هي المستخدمة، فليس هنالك إشكال. ويتأكد الشيء أكثر في الصفحة الحادية والعشرين حين نعود لفكرة أننا مخاطبون بقصة ما، وذلك بقول السارد: "أقول لكم، لو أن عفريتًا انشقت عنه الأرض فجأة، ووقف أمامي، عيناه تقدحان اللهب، لما ذعرت أكثر مما ذعرت".
حلو. نكمل شوي؟ لماذا يقول في الصفحة الثالثة والعشرين "هل خانتني أذناي ليلة البارحة؟" سأرقعها وأقول أن التعبير خانه، إذ لو كان يسرد القصة لنا من زمن لاحق لما قال ليلة "البارحة" بقدر ما يفترض أن يقول الليلة "السابقة". لكن أمرها هين، خصوصًا أن السارد في الصفحة الخامسة والعشرين يعود لمخاطبة القارئ "لا أكتمك أنني ترددت"، ويشدد على كونها قصة قد حدثت كحين قوله في ختام الفصل الأول: "خلاصة القول إنني وعدت وأقسمت"، وفي مطلع الفصل الثالث "كانت ليلة قائظة من ليالي شهر يوليو، وكان النيل قد فاض ذلك العام أحد فيضاناته تلك [...]" فضلًا عن تأكيده لنا بأن سرده لأحداث هذا الفيضان نقل لما حدّثه به والده "فقد كنت في الخرطوم وقتها". وكذا يتأكد في مستهل الفصل الرابع: "لكن أرجو ألا يتبادر إلى ذهنكم، يا سادتي، أن مصطفى سعيد أصبح هوسًا يلازمني في حلي وترحالي. كانت أحيانًا تمر أشهر دون أن يخطر على بالي إنه مات [...]"، وأيضًا قوله بنفس الفصل لاحقًا: "هذا حالي منذ كنت تلميذًا في المدرسة، لم أنقطع عنها إلا في غيبتي الطويلة تلك سبق أن حدثتكم عنها".
أين المشكلة إذن يحسين؟ المشكلة في الهلس الذي يكثر من الفصل الرابع فطالع، هلس سردي تتداخل فيه الأزمنة والساردون، مما يصعّب التوفيق بين الماضي والحاضر وبين قصة السارد ولسانه وقصة مصطفى. قد يقول القارئ مثلما قلتُ حين بدأت الفصل الرابع بأنه يدشن بداية تحول السرد إلى اللحظة الحالية، أي أن السارد ينقل لنا ما يعيشه في تلك اللحظة من خلال سيل وعيه. وليس الدليل على ذلك انتفاء صيغة الماضي وسيادة المضارع، لا. الدليل هو بناء جملة تستخدم الماضي لوصف الحاضر وتفاصيله متصلة ومحاكة ضمن تأملات تنتمي ذات اللحظة. والأمثلة من بعد الفصل الرابع لا حصر لها:
وقفت عند باب دار جدي في الصباح - باب ضخم عتيق من خشب الحراز، لا شك أنه استوعب حطب شجرة كاملة، صنعه ود البصير، مهندس القرية الذي لم يتعلم النجارة في مدرسة، كما كان يصنع عجلات السواقي وحلقاتها، وأيضًا يجبر العظام، ويكوي ويحجم، ويتخصص كذلك في نقد الحمير، قلّ أن يشتري أحد من أهل البلد حمارًا دون مشورته. ود البصير لا يزال حيًا إلى يومنا هذا، ولكنه لم يعد يصنع مثل باب بيت جدي [...]
فهذا الاقتباس قد يوحي للقارئ أن السارد وقف على الباب وذكر لنا ما يجول بخلده أثناء لحظة وقوفه. ويمكن التدليل أيضًا بكمية التفاصيل التي يوردها السارد، حيث ينفجر التكثيف الوصفي فجأة فيصف لنا السارد بيت جده وحجراته وجدرانه، ويصف لنا ما وجده من بروش وبصل حين دخل من باب الحوش. وكذلك ما نجده في مطلع الفصل السادس حين يستفتحه بـ: "قريبًا من الساعة الرابعة بعد الظهر ذهبت إلى بيت مصطفى سعيد، ودخلت من باب الحوش الكبير، ونظرت برهة إلى اليسار، إلى الغرفة المستطيلة من الطوب الأحمر"، أو حين يقول "إنهما أمانة في عنقي، ومن الأسباب التي تحضرني هنا كل عام أن أتفقد أحوالهما". وجمل غيرها من قبيل: "صوتها الآن ليس حزينًا"، أو "بينما كنت أفكر في قول مصطفى سعيد وهو يجلس في هذا المكان عينه، في ليلة مثل هذه"، أو "وأحسست بعطرها ليلة أمس"، أو "الحقول نيران ودخان. هذا أوان الاستعداد لزراعة القمح".
وبالتالي من المنطقي اعتبار أن زمن السرد برمته قد تغير، وصارت الأحداث تُروى بشكل شبه آني. ومن هذا المنطلق، لن يكون من الصعب فهم التداخل السردي بين ما يقوله السارد وما يقوله مصطفى سعيد. طالما ظل الأسلوب متسقًا، فالأمر على ما يرام. لكن فجأة تطالعنا في ختام الفصل الثامن هذه الجزئية:
الذي حدث بعد ذلك ليس واضحًا تمامًا في ذهني. ولكنني أذكر... يدي مطبقتين على حلق محجوب، وأذكر جحوظ عينيه وأذكر ضربة قوية في بطني، وأذكر محجوبًا جاثمًا على صدري. وأذكر محجوبًا ملقى على الأرض وأنا أركله بقدمي. وأذكر صوته يصرخ «مجنون، مجنون». وأذكر لغطًا وصياحًا وأنا أضغط بيدي على حلق محجوب، وأسمع قرقرة، ويدًا قوية تجذبني من رقبتي، ثم وقعت عصا ثقيلة على رأسي
هنا حرت أشد حيرة. يقول السارد أن هذا المشهد غير واضح في ذهنه، ويعتمد في سرده على ذاكرته التي يبدو أنها تأثرت بوقع العصا على رأسه. لكن بمجرد جزمنا بكون هذا السرد استذكاريًا، نقع في مأزق قبال التوفيق بين سرد مبني على توصيف اللحظة الآن، وسرد يعيدنا إلى حيز الاستذكار وقصّ ما وقعت أحداثه في ماض بعيد. والأمرّ أن السارد يعود في الفصل التاسع لزمن اللحظة الآنية ويروي ما رآه حين دخل غرفة مصطفى سعيد المستطيلة ذات السقف المثلث، ويستمر في الفصل العاشر بنفس الأسلوب يروي مشهد دخوله إلى النهر ويصف ما دار في خلده لما دنا منه الموت إبان دخوله ودنو موته. ومن ثم تنتهي الرواية بكلمتي "النجدة. النجدة" دون العودة لمخاطبتنا مجددًا، ودون البتّ في علاقة مشهد النهاية هذا بالقصة التي أخذ السارد على نفسه قصّها لنا.
إذن، أجدني في الحقيقة أمام ثلاثة نصوص مختلفة، لا نصًا واحدًا. هناك نص يرويه لنا السارد باستخدام صيغة الماضي البعيد والخطاب المباشر، وهناك نص يرويه السارد بصيغة الماضي لتوصيف ما يجري له إبان حدوثه عالمًا بكونه ساردًا، وهناك نص سيل وعي يرويه السارد لنفسه وذاته بكل ما تنطويان عليه من هلوسات وتأملات. ولو كان تباين هذه النصوص الثلاثة جزءًا من السرد، أي لو كانت متكاملة أو متمرحلة أو منطقية بأي شكل من الأشكال، لما علقت بشيء. لكن الحقيقة أن تداخلها معطوب ويستحضر أسئلة لا حصر لها.
على ضوء ذلك، أجد من الصعب عليّ تقبل هذا التباين في الأسلوب والأزمنة وترقيعه بكونه تقنية سردية، والأقرب لي أنه مجرد كتابة سيئة مبنية على انفعالات ومزاجات ما يظن الكاتب أن المشهد يتطلبه. هذا يعني بطبيعة الحال أن الأثر الممكن إحداثه على يدٍ أي من المشاهد ينتفي حين يوضع المشهد في الصورة الكبرى، إذ ستتحول الرواية لتوليفة غير متوازنة من الأفكار والأحبولات المنتمية في الحقيقة لعوالم مختلفة لا يربط بينها سوى خيال الطيب صالح.
كم شخصية بالرواية حقًا؟
أستحي أن أقول لكم بأن كل السطور أعلاه عبارة عن نقطة واحدة، وأن هنالك نقطة أخرى ببالي. بس تطمنوا، لن أطيل فيها، خصوصًا إن ملاحظتها سهلٌ قياسًا بالأولى. النقطة كالتالي: كل الشخصيات عبارة عن شخصية واحدة بأسماء مختلفة، إذ ليس هنالك تمايز حقيقي بينها لا على مستوى الأسلوب ولا الأفكار.
ربما راودكم شعور مماثل لما راودني أثناء قراءة الرواية بصعوبة التمييز بين ما يقوله السارد وما يقوله مصطفى سعيد في العديد من المواضع. يعني، لو تجاهلنا الفصل الثاني وكونه سردًا مباشرًا على لسان مصطفى، هنالك الجزئيات التي يتداخل فيها ما يقوله السارد مع ما يقوله مصطفى في سيل وعي متصل. وليست صعوبة التمييز نتيجة سوء تنسيق الطبعة (ولو أن الطبعة التي قرأتها سيئة لدرجة افتقارها لعلامات التنصيص التي تمايز ما يقولانه السارد ومصطفى، الأمر الذي تم تلافيه في طبعات أخرى)، بل تشابه الألفاظ والصياغات والأفكار بين الشخصيتين.
سآخذ اقتباسًا مطولًا أعدت تنسيقه وفق طبعة دار العين لأنها أقرب للدقة في مواضع الفواصل والنقاط:
الظلام يصهر عناصر الطبيعة جميعًا في عنصر واحد محايد، أقدم من النهر ذاته وأقل منه اكتراثًا، هكذا يجب أن تكون نهاية هذا البطل، إنما هل هي فعلًا النهاية التي كان يبحث عنها؟ لعله كان يريدها في الشمال، الشمال الأقصى، في ليلة جليدية عاصفة، تحت سماء لا نجوم لها، بين قوم لا يعنيهم أمره، نهاية الغزاة الفاتحين، ولكنهم، كما قالوا، تآمروا ضده، المحلفون والشهود والمحامون والقضاة، ليحرموه منها. هكذا قال: "رأى المحلفون أمامهم رجلًا لا يريد أن يدافع عن نفسه. رجلًا فقد الرغبة في الحياة. إنني ترددت في تلك الليلة حين شهقت جين في أذني. "تعال معي. تعال". كانت حياتي قد اكتملت ليلتها، ولم يكن ثمة مبرر للبقاء، ولكنني ترددت، وخفت في اللحظة الحاسمة، وكنت أرجو أن تمنحني المحكمة ما عجزت أنا عن تحقيقه. وكأنما أدركوا قصدي، فصمموا ألا يعطوني آخر أمنية لي عندهم. حتى الكولونيل همند الذي كنتُ أتوسم فيه الخير، ذكر زيارتي لهم في ليفربول، وأنني تركت في نفسه أثرًا حسنًا. قال إنه يعتبر نفسه إنسانًا متحررًا ليس عنده تحيز ضد أحد، ولكنه رجل واقعي، وقد كان يرى أن زواجًا مثل ذلك لن ينجح. وقال أيضًا أن ابنته آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقية في أكسفورد، وكانت مترددة بين اعتناق البوذية والإسلام. وهو لا يستطيع أن يجزم إذا كان انتحارها بسبب أزمة روحية انتابتها، أم لأنها اكتشفت خداع مستر مصطفى سعيد لها؟ كانت آن ابنته الوحيدة، وقد عرفتُها وهي دون العشرين، فخدعتها وغررت بها وقلت لها نتزوج زواجًا يكون جسرًا بين الشمال والجنوب، وحولت جذوة التطلع في عينيها إلى رماد، ومع ذلك يقف أبوها وسط المحكمة ويقول بصوت هادئ: إنه لا يستطيع أن يجزم. هذا هو العدل وأصول اللعب، كقوانين الحرب والحياد في الحرب. هذه هي القوة التي تلبس قناع الرحمة"، المهم أنهم حكموا عليه بالسجن، سبع سنوات فقط، ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان عليه هو أن يتخذه بمحض إرادته
اخترت هذه الجزئية لأنني أعتقد أنها خير عينة لأسلوب الرواية ككل. تبدأ السطور على لسان السارد وتساؤلاته، وهي في الاقتباس مكتوبة بخط عريض، ثم تنتقل للسان مصطفى، وتعود في النهاية للسان السارد. وهذا النوع من التداخل السردي مثر إذا ما وظف بعناية. ولكن هل ثمة عناية في هذه الرواية الحقيقة أنكم لو عاودتم قراءة الفصل الثاني، الفصل الذي يسرد فيه مصطفى سعيد قصته على لسانه زعمًا، ستجدون أن من الصعوبة التمييز بينه وبين لسان السارد. قارنوا السطور أعلاه بما يلي:
القاهرة مدينة ضاحكة، وكذلك مسز روبنسن. كانت تريدني أن أناديها باسمها الأول، إليزابيت، لكنني كنت أناديها باسم زوجها. تعلمت منها حب موسيقى باخ، وشعر كيتس، وسمعت عن مارك توين لأول مرة منها. لكني لم أكن أستمتع بشيء. وتضحك مسز روبنسن وتقول لي: "ألا تستطيع أن تنسى عقلك أبدًا؟" هل كان من الممكن تلافي شيء مما حدث؟ كنت عائدًا حينذاك وتذكرت ما قاله لي القسيس، وأنا في طريقي إلى القاهرة: "كلنا يا بني نسافر وحدنا في نهاية الأمر". كانت يده تتحسس الصليب على صدره
العبارات القصيرة نفسها، وكذلك التشبيهات، والتساؤلات التي تتخلل السرد، والانتقال من فكرة لأخرى رغم التباعد المكاني والزماني بينهما. فهل هنالك فرق حقيقي بينهما؟ لستُ أدري.
ماش. سيرقع أحد المستقعدين ذلك قائلًا أن ذلك طبيعي إلى حد ما، فالسارد هو الذي يروي لنا كل شيء في نهاية المطاف، ولا شك أنه طبع السرد بأسلوبه ونبرته ومفرداته. ترقيعة حلوة، ولكنها تتهاوى بمجرد استحضار تشابه الأفكار بين الشخصيتين والشخصيات الأخرى.
مثلًا، مثلًا مثلًا، فلنأخذ فكرة التعليم في سياق واقع أهل القرية. كم شخصية ذكرت العلاقة بين التعليم والواقع؟ فلنحسب. ذكرها مصطفى سعيد في أول حديث له مع السارد: "نحن هنا لا حاجة لنا بالشعر. لو أنك درست علم الزراعة أو الهندسة أو الطب، لكان خيرًا". وذكرها ريتشارد متحدثًا عن مصطفى سعيد: "لو أنه فقط تفرغ للعلم لوجد أصدقاء حقيقيين من جميع الأجناس، ولكنتم قد سمعتم به هنا. كان قطعًا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الذي تتحكم فيه الخرافات". وذكرها ود الريس غاضبًا من فشل وساطة السارد في إقناع بحسنة بالزواج منه: "ما دخلك أنت؟ أنت لست أباها ولا أخاها ولا ولي أمرها. إنها ستتزوجني رغم أنفك وأنفها. أبوها قبل وأخواتها قبلوا. الكلام الفارغ الذي تتعلمونه في المدارس لا يسير عندنا. هذا البلد فيه الرجال قوامون على النساء". وذكرها محجوب يعلل اكتفاءه بالتعليم الأولي: "هذا القدر من التعليم يكفي، القراءة والكتابة والحساب. نحن ناس مزارعون مثل آبائنا وأجدادنا. كل ما يلزم المزارع من التعليم، ما يمكنه من كتابة الخطابات وقراءة الجرائد ومعرفة فروض الصلاة". وذكرها السارد في معرض استحضار خطاب الوزير الذي قال فيه: "يجب ألا يحدث تناقض بين ما يتعلمه التلميذ في المدرسة وبين واقع الشعب". والأهم من كل ذلك، ذكرها السارد في حديث نفسه بالفصل الثالث: "صحيح أنني درست الشعر، بيد أن هذا لا يعني شيئًا. كان من الممكن أن أدرس الهندسة أو الزراعة أو الطب. كلها وسائل لكسب العيش".
لاحظوا طبعًا أنه ذكر الهندسة والزراعة والطب كما ذكرها مصطفى سعيد في الفصل الأول، وبنفس الترتيب. ما علينا. لسه لستم مقتنعين؟ لنجرب تكرر فكرة أخرى: كم شخصية تكلمت عن الاستعمار والحداثة على الطالعة والنازلة بسبب أو بدون؟ فلنحسب. ذكرها بروفسور ماكسول في محاماته عن مصطفى سعيد بالمحكمة: "مصطفى سعيد يا حضرات المحلفين إنسان نبيل، استوعب عقله حضارة الغرب. لكنها حطمت قلبه". وذكرها المأمور المتقاعد الذي حكى للسارد حكايته لما كانا جالسين في القطار. وذكرها ريتشارد استكمالًا لحديثه عن التعليم ونقاشه مع منصور: "كل هذا يدل على أنكم لا تستطيعون الحياة بدوننا. كنتم تشكون من الاستعمار، ولما خرجنا خلقتم أسطورة الاستعمار المستتر". وذكرها عبد المنان عم السارد في تحلطمه على الأحزاب: "كنا مرتاحين أيام الإنكليز من هذه الدوشة". وذكرها السارد مجددًا لما وقف عند باب غرفة جده: "نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي، فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى، كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه". وذكرها مصطفى سعيد على لسان محاميه نفسه: "أنت يا مستر سعيد خير مثال على أن مهمتنا الحضارية في أفريقيا عديمة الجدوى، فأنت بعد كل هذه المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك تخرج من الغابة لأول مرة". وذكرها مصطفى سعيد أيضًا واصفًا نفسه بالمحكمة: "وأنا أحس تجاههم بنوع من التفوق، فالاحتفال مقام أصلًا بسببي، وأنا فوق كل شيء مستعمر، إنني الدخيل الذي يجب أن يبت في أمره". وذكرها محجوب وهو يخاطب السارد حول رفض حسنة الزواج من ود الريس: "الدنيا لم تتغير بالقدر الذي تظنه. تغيرت أشياء. طمبات الماء بدل السواقي، محاريث من حديد بدل محاريث من الخشب. أصبحنا نرسل بناتنا للمدارس. راديوهات. أوتومبيلات. تعلمنا شرب الويسكي والبيرة بدل العرقي والمريسة. لكن كل شيء كما كان". كما ذكرتها إليزابيث في رسالتها إلى السارد: "وسأكتب عن الدور العظيم الذي لعبه موزي في لفت الأنظار هنا إلى البؤس الذي يعيش فيه أبناء قومه تحت وصايتنا كمستعمرين".
سبحان الله. كل شخصية تجد سببًا لاستحضار الفكرة على اختلاف خلفيتها الاجتماعية وعلى اختلاف موضوع السالفة وعلى اختلاف السياقات. أتفهم مثلًا ورودها في نقاش منصور وريتشارد، وأتفهم أيضًا وجودها في تأملات السارد. لكن أن يذكرها المحامي في محاماته؟ أن يذكرها محجوب وهو يتحدث عن رفض حسنة لود الريس؟ ماش. ربما تغلب الكاتب على السارد مجددًا.
على كثر الثرثرة السابقة، أمتلك في جعبتي المزيد عن البناء السيء للشخصيات الرئيسية مثلًا. لست الوحيد الذي فوجئ لما ذكر السارد زوجته وأبناءه، ولا الوحيد الذي ضحك لما عبر السارد عن حبه لحسنة وهي التي غابت عن أغلب السرد حتى لحظتها. ولا أظنني الوحيد الذي يجد شخصية مصطفى سعيد غير مقنعة لا في أفعالها ولا قناعاتها ولا غموضها المزعوم. وليس هذا فقط. يمكنني الثرثرة أكثر عن الخلل السردي المتمثل في قفزات السارد أعوامًا وأشهر حسب المزاج. أو عن اصطناعية المكان والفضاء في أحداث الرواية. أو عن النهاية السخيفة، إن صح تسميتها بالنهاية. ولكن سأكتفي بهذه السطور وقلبي مطمئن أني أضعتُ من وقتكم قليلًا كما أضاعت الرواية من وقتي كثيرًا. وحدة بوحدة.
وإذا كان من بقية، فسأوفرها لحلقة كتبيولوجي.



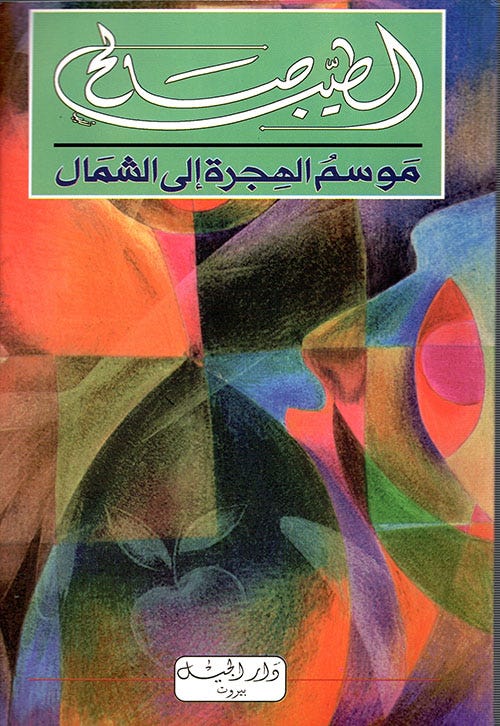
انا مستعد ادفع لك ١٥٠٠ ريال (أقساط طبعا) مقابل تنتقد روايات عبدالرحمن منيف
احسنت. هذه رواية ركيكة بولغ باهميتها بشكل يثير الغثيان حقيقة، مثل الكثير من روايات ما-بعد-الاستعمار وهذا الامر بمثابة سر لا يجرؤ احد على قوله خصوصا في اوساط الاكاديميين. شكرا جزيلا على هذا النقد الجدي الذي يحترم الأدب وفن الرواية.