خمسة كتب غيرت حياتي في ٢٠٢٣ (للأسوأ)
عن القراءات التي خيبت أملي
لا شيء يثير حنقي في السنوات الأخيرة أكثر من الإحساس بأن وقتي قد ضاع. للتنويه: لست عبد إنتاجية واستغلال الوقت حسب العقيدة الشركاتية اللنكدإنية، ولست أقيس إضاعة الوقت على بضع دقائق تمر وأنا عالق في زحمة تحويلة كوبري شارع الملك سعود. ما أعنيه أبسط من ذلك بكثير: الوقت الضائع عندي هو الوقت الذي قضيته أمارس شيئًا دون أن تتحقق النتيجة المرجوة من وراء ممارسته. سهل، صح؟
مثلًا، إذا شاهدت فيلمًا كوميديًا بغرض توسيع صدري ثم لم أضحك طواله، فهذه إضاعة وقت. وإذا التزمت بحمية مدة شهر لأجل إنزال وزني ثم انتهى الشهر وكرشتي ما تزال تتدلى بنفس الحجم والرقم على الميزان، فهذه إضاعة وقت. وإذا قرأت كتابًا على أساس إحراز هدفٍ ما ثم لم يتحقق بانتهائه، فهذه أيضًا إضاعة وقت. يرتبط الموضوع دائمًا بهدف يرجى تحقيقه من خلال الإقدام على الفعل ابتداء. هذا يعني أني لو مارست الشيء نفسه بهدف آخر يراودني لاختلف الوضع على الأغلب.
ولكن لسوء حظي، لا تمشي الدنيا دائمًا على مزاجي رغم تقلباته. حاله حالها. كثيرًا ما يحدث أن أباشر قراءة كتابٍ على أساس غاية معينة، وفي النهاية أجدها ما تزال بعيدة المنال. وبعد تفكير قصير جدًا، من باب تغيير الجو عن خربوشة ١٢ شهرًا و١٢ كتابًا المعتادة، قررت كتابة خربوشة عن أسوأ خمسة كتب قرأتها في العام المنصرم قياسًا على الأوقات الضائعة فيها. ومجددًا أنوه: ضياع الوقت هنا نسبة لدوافع قراءتي، ولربما يختلف الحكم مستقبلًا باختلاف الدافع. ربما.
قرأت الرواية اجتهادًا شخصيًا في التحضير لورشة عمل لم يكتب لها الحدوث. حين وصلني خبر إلغاء الورشة، كنت قد قرأت أقل من نصف الرواية البالغ عدد صفحاتها قرابة الأربعمئة. ولذا كنت حرًا في ألا أواصل القراءة، خصوصًا وأن شخصياتها أصابتني بالغثيان وجعلتني أبغضها واحدة واحدة حتى قبل أن أكمل خمسين صفحة. ولكني تذكرت وعدًا قطعته على نفسي بداية ٢٠٢٣ بأن أتعلم طولة البال. ومن هذا الباب قررت إكمالها. والمؤسف أن الحال ظل على ما هو عليه طوال الصفحات المتبقية: سرد متذبذب وشخصيات بغيضة وأحداث متضاربة أحاسيسها. لدرجة أني كتبت في مفكرتي هذا الموجز عنها بمجرد إنهائها: رواية عن مجموعة مختلين أول فكرة تخطر بذهنهم بعد التحية هي ”هل تتزوجيني“؟
تتقصى الرواية قصة بطلتها جمورة، المولودة لأب أردني وأم أمريكية توفيت بسن مبكرة، وهي تجابه الحياة بمجتمع فقير شمالي نيويورك. وكما خمنتم، تتمحور أجزاء كبيرة من الرواية حول ثيمات الهوية والغربة والروابط الأسرية والطبقة الاجتماعية/الجندرية. كل واحدة من هذه الثيمات تجذبني على حدة، ولكني لم أستسغ خلطتها في رواية جاز عربي. وربما سبب خيبة أملي الرئيسي هو أني رفعت سقف تطلعاتي بعد قراءة رواية هلال للكاتبة نفسها، والتي تطرقت لبعض هذه الثيمات بشكل أكثر تكاملًا وبأسلوب أكثر سلاسة.
لو قرأت الرواية من زاوية علاقة السرد بثيمة المهجر، أو بالكيفية التي يتغير من خلالها الشكل الأدبي نتيجة تحدي القوالب المسبقة ممن يقبع بالهامش، لكانت قراءتها أهون بالطبع. لكن اهتمامي قد انصب على جوانب مختلفة ولأسباب مغايرة، ما يجعلني أعتبر قراءتها مضيعة لوقتي.
2. المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك - عبد العزيز حمودة
لا أعرف كم ظلت كتب حمودة الثلاثة تجمع الغبار على أرفف مكتبتي. ما أعرفه هو أني حينما عزمت البدء في قراءة حمودة أخيرًا، شرعت في كتاب الخروج من التيه لأني كنت مهتمًا بأطروحته حول سلطة النص وكيفية الخلاص من لعنة القراءات الموغلة في النصية. لكن حين قرأت في مقدمته بأنه امتداد لكتابي المرايا المحدبة و المرايا المقعرة، قلت خلاص يا حسين ما لك إلا تقرأهم قبل عشان تفهم أطروحة الخروج من التيه بشكل أفضل. وفعلًا أغلقت الكتاب وبدأت قراءة المرايا المحدبة بحماس منقطع النظير (متعوب عليها).
من المفترض أن الكتاب يتناول المدارس النقدية الغربية (من البنيوية للتفكيك كما يشير عنوانه الفرعي) من زاوية نقدية بدورها. بعبارة أخرى، لا يسعى الكتاب لاستعراض المدارس النقدية ورموزها وأبرز إسهاماتها (كما تفعل كتب تواريخ النقد الأدبي وما أشبه) بقدر ما ينقد مفاهيم النص والنقد المتضمنة في كل مدرسة، وكيفية تأثيرها على تعاطينا مع الآداب. والهدف من وراء الطرح تبيان مواطن القصور والخلل التي تبرهن على أهمية الخروج عن هذه التيارات وإحلال نقد عربي أصيل مكانها. سو فار سو غود.
لكن سرعان ما يقع الكاتب في فخاخ ما يود الخلاص منه. ففي حين يدعو مثلًا للثورة على استيراد المصطلح التحليلي الغربي (فكرة جيدة)، نجده يستخدم مفهوم الحداثة بصفتها ظاهرةً فلسفية/ثقافية ذات حياة مستقلة وقابلة للتأريخ أكثر من ثلاثمئة سنة للوراء. هذا غير أن السواد الأغلب من طرحه النقدي "مستورد" بدوره من نقاد ومنظرين غربيين (دون حضور حقيقي للنقد القابع خارج إطار المركزية الغربية)، وغير أنه يتعاطى مع مفهوم الأدب من نفس المنظور التشييئي المعطوب الذي تستعمله الأكاديميا. وبالتالي لا أعرف ما إذا كان الهدف المرجو من الكتاب قد تحقق فعلًا فيه أو أنه أُجل لكتاب الخروج من التيه.
ربما كنت سأواسي نفسي لو قرأت المرايا المحدبة في معرض دراسة مقارنة لمخرجات النقاد الأدبيين العرب وتأثر منهجيات نقدهم ومواضيعها بالأكاديميا الغربية. حينها سيكون الكتاب كنزًا من البراهين على هذا الخلل. ولكني قرأته على ضوء ما ورد في المقدمة بكونه مخرجًا نقديًا جذريًا يدعو للخروج من عباءة النقد الغربي، ولذا أعتبرني ضيعت وقتي حين لم يتحقق ذلك.
أتحمل جزءًا من مسؤولية وجود رواية ستونر على قائمة أسوأ قراءات ٢٠٢٣. جزءًا بسيطًا وحسب، وذلك لأني أعطيتها ثلاث فرص مختلفة ولم أتخلص منها حالما راودتني فكرة أنها لا تصلح لي. حاولت قراءتها أول مرة قبل عامين تقريبًا. قرأت بضع صفحات، وأدركت أنها تحتاج طولة بال (تذكروا، قراري بتعلم طولة البال لم أتخذه إلا مطلع العام الفائت)، وتركتها لوقت لاحق. ثم بدأت قراءتها مرة ثانية مطلع شهر يونيو الماضي. ومع أني كنت في كامل روقاني، وجدتني أجبر نفسي على الاستمرار في البرغرافات التي لا يفوقها مللًا سوى شخصية ستونر نفسه. ووسط زحمة تجهيز شنطة الرق (الـrig، وليس الرق من العبودية، مع أننا جميعًا عبيد تحت الرأسمالية #عمق)، نسيت أخذ الرواية اللي تبقى منها أقل من نصفها بقليل. تولدت لدي فرصة ذهبية لئلا أواصل قراءتها، إذ أن أسبوعين فترة مناسبة تتيح لي نسيان الأحداث البائخة، وهي بالتالي فرصة لأوفر وقتي وأحفظ سلامة أعصابي وأمتنع عن إصدار أحكام جزافية على الذين أعجبتهم ستونر. لكن هيهات. حسين يتعلم طولة البال، وظل مؤمنًا بأن في نهاية الرواية ما يجعل أحاسيس "ودي أشق ثيابي" التي راودته تستحق العناء.
تتقصى الرواية قصة حياة بطلها الممل ستونر وهو ينشأ نشأة مملة ومن ثم ينضج نضجًا مملًا ويتزوج زواجًا مملًا ويعمل في وظيفة مملة، ثم تنتهي حياته نهاية مملة. هناك بضع شخصيات أكثر إثارة للاهتمام منه، ولكن لا نعرف عنها شيئًا للأسف إلا من خلال عيني ستونر المملتين.
هذه الرواية تجسيد أدبي للمدرس ذي درجة الصوت المنخفضة والنبرة الأحادية، الذي ينام المرء في حصته دون شعور. والسياق الوحيد الذي يخطر ببالي لئلا تعتبر مضيعة وقت هي استخدامها كمنوم أنجع من كل حبوب الميلاتونين أو الدريم ووتر. وهي حتمًا من الروايات التي سأوصي بها أعدائي.
4. موسم الهجرة إلى الشمال - الطيب صالح
لو قرأت موسم الهجرة إلى الشمال فقط من باب أنها تعتبر من كلاسيكيات الأدب العربي، لكنت على الأقل أنهيتها كي أشطبها من القائمة. لكني أكره فكرتي الكلاسيكيات والقوائم أصلًا، فمثلما رحتي جيتي.
كتبت خربوشة كاملة ومفصلة عما يجعل الرواية مضيعة وقت بالنسبة لي. خلاصتها أني كنت أمني النفس بعمل عظيم عطفًا على اعتبارها من أفضل الروايات العربية في القرن العشرين وعلى تصنيفها كأدب ما-بعد-استعماري يناهض أسس الأدب المهيمن، لكني فوجئت بعمل ضعيف على كلا الصعيدين. وسأقول مثلما قلت للبكاية الذين كتبوا التغريدات قائلين أني بصوب والثقافة بصوب: يمكن قراءة لا تبكِ أيها الطفل المنشورة قبل موسم الهجرة بعامين، والتي تتشارك معها سياق الاستقلال من الاستعمار البريطاني بعيني شخصية "متعلمة" تعليمًا غربيًا، ليدرك القارئ أن حجة "إمكانيات" ذاك الوقت حجة ساذجة، تمامًا كأجوبة البكاية حين تسألهم عما أعجبهم في الرواية بحد ذاتها دون نوستالجيات فترة قراءتهم لها. صدق، ما عندي خلق لكي أستحضر أحداثها أو حبكتها هنا. اقرؤوا خربوشة جذور رداءة الرواية العربية وبس.
لا أذكر صراحة متى اقتنيتها ولا من وصاني بها. المهم أني قررت يومًا ما قراءتها دون تخطيط ولا هدف مسبقين غير سياقها التاريخي. كما يشير عنوانها، تدور الروايا حول وصايا. وتحديدًا حول عشر وصايا من جدٍّ على فراش الموت لحفيده "الساقط" كما نتعرف عليه مطلع الرواية. ومع كل وصية، نتعرف عن طريق الجد عبدالرحمن على جزء من تاريخ عائلته، عائلة سليم، وأجيالها المتعاقبة على مدار القرن العشرين. كل وصية درس تعلمه الجد من خلال رحلته بحياة قاسية، وكل درس يكشف لنا الغطاء عن الديناميكيات الاجتماعية وسط التحولات السياسية والاقتصادية بالمنطقة. وآخر دعوى الجد أن يتعلم حفيده الوصايا والدروس ليتعظ منها ويحافظ على تماسك العائلة.
أدين للرواية بأمرين: أولًا، كونها ساهمت في تعليمي طولة البال. وثانيًا، كونها علمتني الفرار من أي رواية يرد في وصفها اعتمادها على السرد المكثف أو ما أشبه. ومثلما أسلفت ذكرًا، قرأتها لأنها تسلط الضوء على الريف المصري تحديدًا في حقبة تزايد اهتمامي بها، فضلًا عن كونها بدت مكتوبة بألاعيب سردية وتقنيات تعجبني. لكن سرعان ما اتضح أن السرد المكثف ليس إلا تورية لتداخل الأحداث والشخصيات بشكل يثير الحيرة أكثر مما يثير الاهتمام، فضلًا عن كونه مواراة لركاكة بناء الشخصيات وفشلها في خلق أي عالم بمعزل عن السارد/الكاتب الذي أخذ على عاتقه الأدوار كلها، لا سيما دور المؤرخ الواعظ المتفلسف الذي يخاطب القراء ويؤكلهم الثيمات أكلًا.
كانت النية أن أكتب خربوشتي المعهودة مطلع كل عام عن أفضل ١٢ كتاب قرأته خلال العام بالتزامن من حلقة كتبيولوجي بنفس العنوان والمضمون. لكن صديقي عماد يقول: “الله يخليك حسين من فاضي يسمعك تبربر عن ١٢ كتاب؟ ترى من تنتقل لكتاب ننسى وش قلت عن اللي قبله”. ولذا قررت تغيير الجو بهذه الخربوشة. لكن ما زلت أتساءل، هل أعود لكتابتها؟




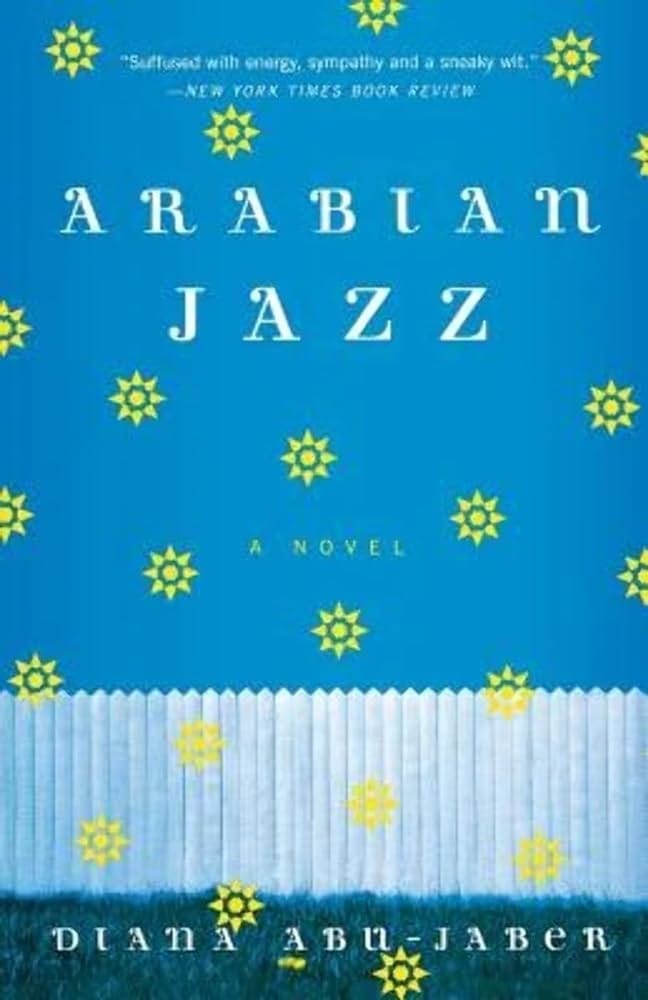

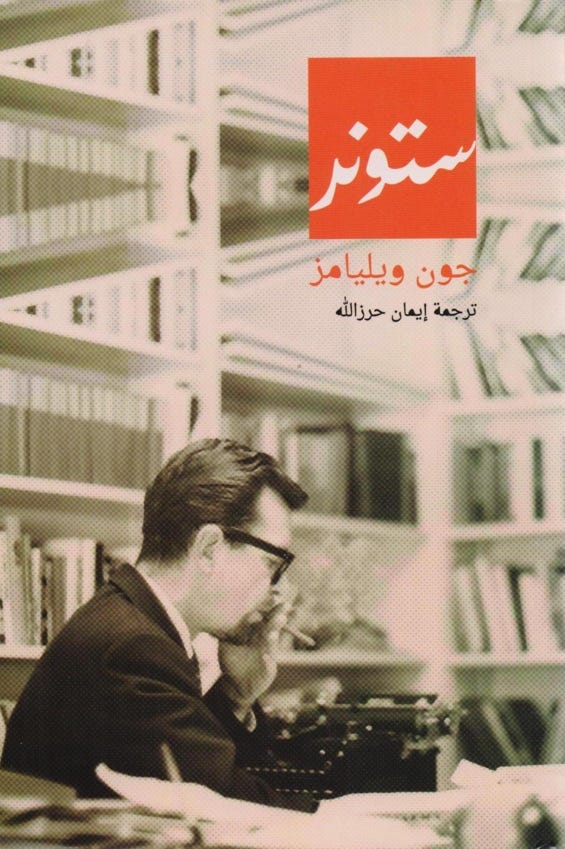

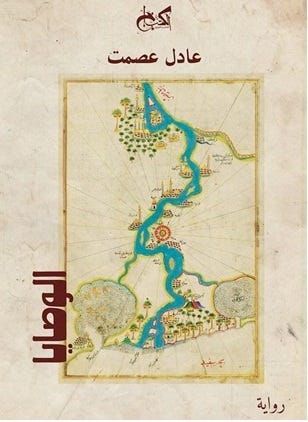

إنه لمن المضحك والمثير للسخرية معاً، كيف أني ما زلت أعتبر أي نقد موجه لستونر هو بمثابة إهانة شخصية لي، لذا لم استطع منع نفسي من كتابة هذا التعليق في محاولة الدفاع عنها قليلاً.
ويعود ذلك بشكل أساسي لارتباطي العميق بالرواية، في الوقت الذي قرأتها فيه قبل قرابة الثلاث سنوات، ومع أني لم أُعد قرائتها من ذلك الحين، إلا أني بالتأكيد أخطط لفعل ذلك في وقت قريب، وأنا موقنة أن مشاعري ورأيي فيها سيكون مختلفاً في المرة الثانية،
.لاختلاف ظروفي الحياتية عن تلك التي قرأتها فيها،
ومع أني اعترف أني لا أذكر كل شيء بشأنها حالياً، إلا
أني أذكر جميع المشاعر الإيجابية والابتسامات البلهاء التي ارتسمت على وجهي وأنا أتنقل بين صفحاتها، مصادفة في ذلك الوقت ما بدا لي أكثر سرد شفاف وقابل للارتباط به، قد مر علي بالمطلق
أذكر أيضاً شعور ستونر العميق بالعزلة، واغترابه عن الواقع المحيط به، وما قد يراه الآخرين مللاً في شخصيته، وعيباً فيها، بان لي كاستسلام عميق للواقع، وهي الفلسفة التي ارتأيت أن ستونر قد تبناها، منذ صغر سنه، كآلية دفاعية، استجابة لظروف حياته الغير مثالية منذ بدايتها.
بالإضافة إلى لغة السرد الجاذبة حد التخدير، والندبات
الشعورية المحفورة عميقاً في دواخل ستونر، ما شدني إلى الرواية وقتها، هو الوصف الهادئ لتلك اللحظات الصغيرة التي من شأنها أن تُحدث أكبر وأكثر التغييرات دراماتيكية في حياتنا، ليس بسبب اللحظات بحد ذاتها بل بسبب الطريقة التي نقرأ ونترجم فيها هذه اللحظات، ومن ثم كم المعنى الذي نصبغه عليها، بعد تبنيها وحفرها في ذاكرتنا، وبالنسبة لستونر كان هنالك العديد من هذه اللحظات، التي ويا للمفاجأة لامستني أنا أيضاً، وإحدى الأمثلة عليها هي اللحظة التي شعر فيها ستونر بخروج نفسه من جسده، ومراقبتها لكل ثقل وجوده ينبسط أمامه أثناء درس اللغة الإنجليزية وحواره مع أستاذه، كاشفاً له عن أمر يستمتع حقيقية به، وربما الأمر الوحيد الذي سيضفي على حياته المعنى.
نهاية، لم أرد حقاً لهذا التعليق أن يغدو مقالة كاملة، لكني لم استطع مقاومة اغتنام فرصة المدافعة عن ستونر، أمام من يعدها مملة الأحداث والشخصية، لأن هذا الملل وانعدام البطولية في الرواية والشخصية الرئيسية هو انعكاس حقيقي لمعظعم حيوات البشر من حولنا، فلسنا كلنا أبطالاً، ولسنا كلنا نبتغي تغيير العالم، وإحداث زوبعة من التغييرات أينما حللنا، وأنه ربما تكون أكبر العقد في حياتنا هي مجرد فكرة وجودنا بحد ذاته، كما العقدة الرئيسية لشخصيتنا الرئيسية (ستونر)، وليس لنا إلا الاستسلام والتعامل مع هذا الوجود.
أكيد لا غنى عن حلقة وخربوشة ١٢ كتاب ١٢ شهر
عالأقل كتب أعجبتك، ومابيضيع وقتك وانت تكتب عن كتب اضاعت وقتك